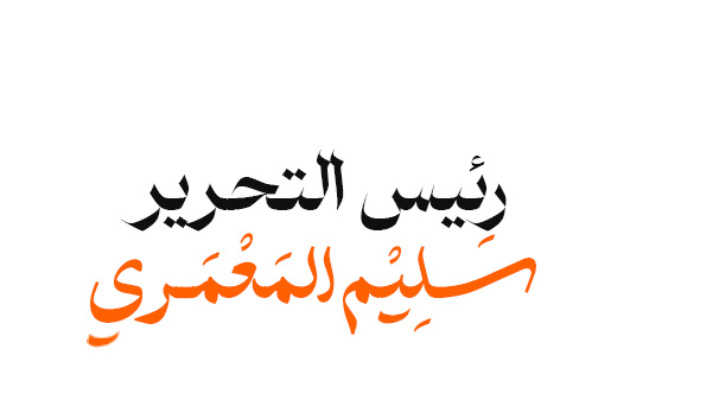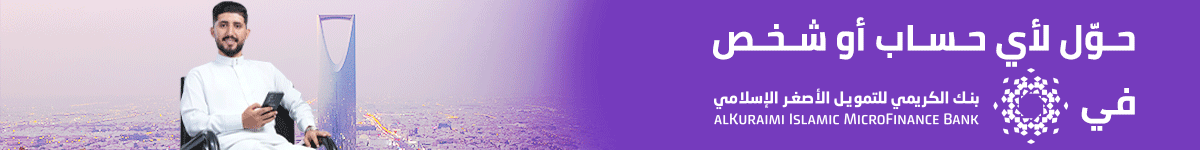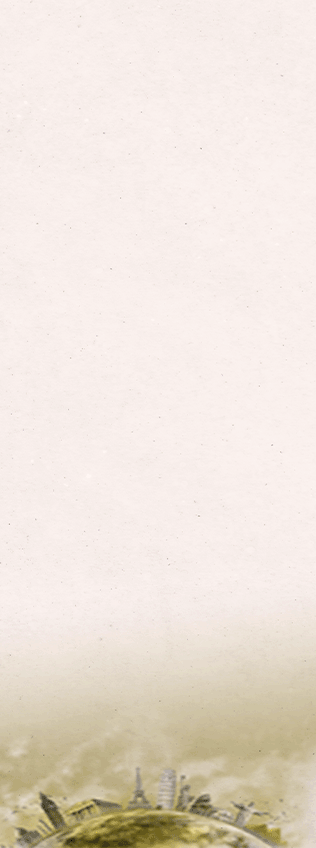هشاشة التنظير السوسيولوجي العربي مع مجدي حجازي..
بروفيسور / قاسم المحبشي...
استوقفتني الندوة التي نظمتها وحدة الدراسات الاجتماعية والإنثروبولوجية بالمعهد العالمي للتجديد العربي البارحة بتاريخ 12 فبراير 2025م بعنـــــــــوان " هشاشة التنظير في علم الاجتماع، رؤية نقدية حول التغريب وتسليع المعرفة"، قدمها الدكتور، مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي والتنمية الثقافية، وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، وعقبت عليه د. ابتسام ساتي ابراهيم،أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم بالسودان. وأدارها الدكتور خضير المرشدي..
اقول استوقفتني بموضوعها الذي يهمني وطالما وقد شغلني من زمن طويل إذ أتذكر بانني كتبت مقالات مطولة في اهمية النظرية والتنظير في العلوم الاجتماعية والانسانية وفي الفروق المنهجية بينهما وبين العلوم الطبيعية التي تعتمد منهج التجريب والاستقراء والتفسير بينما العلوم الاجتماعية والإنسانية تعتمد منهج الوصف والفهم والتحليل" أننا نفسر الظواهر الطبيعية ونفهم الظواهر الإنسانية..
فإذا كان بإمكاننا دراسة الظاهرة الطبيعية دراسة تفسيرية، فإنه لا يمكن ذلك مع الظاهرة الاجتماعية والإنسانية إذ يصعب تصنيف الاشخاص كما نصنف الطيور أو تشريح أجساد البشر كما يفعل العلماء مع الحيونات. الظاهر الاجتماعية ، ينبغي أن تخضع لمنهج الفهم والتأويل إذ يقوم المنهج التفهمي_التأويلي على إدراك المقاصد والنوايا والغايات التي تصاحب الفعل، والتي تتحدد بالقيم التي توجهها، ويتم النفاذ إلى هذه الدلالات عبر التأويل. وهنا تحضر الذات بقوة في عملية الفهم والتأويل كذات مدركة وعارفة وفاعلة ، لكنها في الوقت ذاته متعاطفة ومتوحدة ومشاركة ومتفهمة لموضوعها..
وهكذا يكون السؤال العلمي في الظاهرة الإنسانية والاجتماعية ليس ماذا يعتقد الناس ويقولونه ويفعلونه؟ بل لماذا يعتقدون بما يعتقدونه؟ ويفكرونه؟ ويقولونه ويفعلون ما يفعلونه؟! فإذا كنا نفسر الحرائق التي تشب في الغابات بسبب اشتعال عود ثقاب أو شرت كهرباء أو برق رعدي ( صواعق ) فمن المستحيل تفسير قيام الثورات بسبب وحيد أو عدة أسباب واضحة أو حتى تفسير طلاق زوج لزوجته..
الظاهرة الاجتماعية والإنسانية هي ظاهرة شديدة التداخل والتعقيد كما أكد الفيلسوف الفرنسي ادغار موران إذ يرى "المنهج» المُناسب، في نظر إدغار موران، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تعقيد الواقع والناس، وانفتاحهما على عناصر المفاجأة واللايقين: إن قرارا مُتَّخَذًا في البداية قد يُخلف ردود فعل غير متوقعة قد تُؤثر على القرار نفسه. لقد استوعب صاحب البراديغم المفقود، مقولة باشلار («البسيط هو المُبَسَّط دائما») جيدا، وسعى إلى بناء معالم فكر مُعقد يقوم مقام الفكر المُبَسَّط السائد في الغرب منذ أكثر من أربعة قرون..
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم «التعقيد»، لا يجب أن يؤخذ بمعناه القدحي، أي «التَّعَقُّد» فكيف نفهم الظاهرة الاجتماعيّة بدون خيال سوسيولوجي خلاق؟ تخيل أنك معني بدراسة ظاهرة الحروب الطائفية في المجتمعات العربية والإسلامية الراهنة. هل يكفي أن تتبعها تاريخيا منذ سقيفة بني ساعدة ومقتل الخليفة عثمان ابن عفان حتى الآن؟ هب إنك أحصيت مئات من الحروب الطائفية التي نشبت بين طوائف المسلمين في كلّ مكان وزمان؟ فماذا يفيد مثل هذا التتبع والإحصاء؟ لا شيء إذ لم نضعه في إطار نظري ونمنحه المعنى المفهومي..
إذ يُعَدُّ التنظير ركيزة أساسية في تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ يسهم في بناء الأطر المفاهيمية التي تفسر الظواهر الاجتماعية والثقافية والنفسية والسياسية والتاريخية. وبدون تنظير، تبقى هذه العلوم محصورة في نطاق الوصف والتفسير الجزئي، مما يحدّ من قدرتها على تقديم رؤى متكاملة وعامة. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التنظير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ووظائفه، والتحديات التي تواجهه، وأثره في تطور المعرفة الإنسانية. وهذا هو الذي يستدعي التنظير في العلوم الاجتماعية والإنسانية وبدون النظرية يظل الناس يكررون الحالات ذاتها بلا أفق عقلاني لتجاوزها ..
أن حاجة العرب لتعلم التفكير نظريات أكثر من حاجاتهم لتعلم النظريات ذاته فما الذي يفيد تعلمنا لنظرية الانتحار عند عالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم؟ كم تسأل الدكتور أحمد مجدي حجازي في كتابه المهم أزمة علم الاجتماع العربي. وقد حدثنا البارحة عن المحاولات التنظيرية العربية في ثلاث مراحل : مرحلة التبعية المعرفية الكاملة ومرحلة المحاكة المنهجية ومرحلة المحولات التنظيرية المستقلة. في الواقع اتفق مع الدكتور مجدي أنه يمكن لنا استيراد كل شيء بما في ذلك العلوم الطبيعية ونظريات وادواتها ..
أما العلوم الاجتماعية والإنسانية من المستحيل استيرادها مثلها مثل ( الدول المستوردة) بحسب برتراند بادي.
إن حاجة المجتمعات العربية للنظريات المنتجة من واقعها المتعين تفوق حاجتها إلى استيراد السلع والأسلحة. لا تطور ولا تقدم ولا نماء ولا ارتقاء بدون معرفة الطبيعة ومظاهرها وفهم قوانين حركتها والتنبؤ بنتائجها وتلك هي وظيفة العلوم الطبيعية ولا تطور ولا تقدم ولا نماء ولا ارتقاء في التاريخ والحضارة الا بمعرفة حقيقة الكائن الإنساني والمجتمع البشري بوصفهما لحمة التاريخ وسداه؛المعرفة القادرة على فهم حاجات الإنسان ودوافعه ومقومات الحياة الاجتماعية المدنية المستقرة وقوانين التاريخ وحركته والتنبؤ بمساراتها المستقبلية وتلك هي وظيفة العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة في قلبها بل هي أمها التي ابدعت اخصب وانضج المفاهيم الأساسية في تاريخ المعرفة الإنسانية( الوجود، الإنسان، العقل،
الخير، الشر، العدل ، الحرية، الجمال ..الخ) وذلك منذ البواكير الاولى للفكر الفلسفي الشرقي واليوناني القديمين مرورا باللحظة العربية الإسلامية الخصيبة لحظة الترجمة والتفلسف في المشرق والمغرب العربي وانتهاء بالعصور الحديثة والمعاصرة..
إذ لم تكن الحداثة الغربية في معناها الاوسع إلا مشروعا فلسفيا عقلانيا قرر اعادة تأسيس وبنا المجتمع من جميع جوانبه على أسس علمية عقلانية إنسانية شاملة. غير أن الانتصارات المذهلة التي حققتها العلوم التجريبية جعلتها في لحظة أوجها تستغني عن أمها الفلسفة والعلوم الإنسانية في منتصف القرن التاسع عشر حينما حلم اوغست كومنت بتأسيس فيزياء أجتماعية على قرار منهج الفيزياء في دراسة الظاهرة الطبيعية وهذا أمر غير ممكنا بسبب اختلاف الظاهرة الاجتماعية وطبيعتها الشديد التعقيد والتركيب..
نعم انتصر العلم والتكنولوجيا فظهرت مشكلات جديدة لاسابق للخبرة الإنسانية بها فعادت الدعوة إلى المنظور التكاملي للمعرفة العلمية وذلك بتأكيد البعد السيوسيولوجي للعلم، ونسبية الحقائق العلمية، ومبدأ الكشف، وقوة الخيال والمغامرة، وأسبقية الفروض الحدسية وحيويتها قد أفضى إلى إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والاجتماعية. ويقر بيير بورديو بفضل الأفكار التي طرحها توماس كون، بقوله: إنني أنسب الفضل لتوماس كون، في أهم جزء قدمته فيما يتعلق بمنطق الممارسة والديناميات التي تحتويها. ويقدم توماس كون نظرية في الممارسة العلمية تثير أكثر الأسئلة إشكالية بالنسبة لسوسيولوجيا العلم، والمتعلقة بالتغير، كيف يحدث وما هي آلياته، وما هي الشـروط التي ينشأ فيها العلم الجديد أو النموذج الجديد، وما هي التأثيرات الخارجية المفروضة على المجال العلمي..
كما أن حجم ونوعية المشكلات الإنسانية والاجتماعية التي أفرزتها المتغيرات التاريخية والحضارية العالمية المتسارعة اليوم تستدعي الحاجة الملحة إلى ردم الهوة الشاسعة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، والنظر إلى المشكلات ومواجهتها وبحثها بصيغة تكاملية ورؤية عقلانية نقدية. جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية ومشكلة سباق التسلح والحروب والأمن والسلام الدوليين، ومشكلات البيئة الأرضية والأوزون، وصدام وحوار الحضارات، ومشاكل الاقتصاد والتجارة والمال والأعمال العابرة للقارات. ومشاكل الفقر والصحة والمرض، ومشكلة التطرف والإرهاب والعنف، ومشاكل الهويات الطائفية والتعددية الثقافية، والأقليات والتمييز والتعصب والاستبعاد الاجتماعي، والهجرة غير الشرعية والاندماج، والمخدرات ومشكل الفساد والبطالة و والحركات الاجتماعية والثورات، وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب، وكل ما يتصل بالحقوق المدنية، ومشاكل التربية والتعليم والجودة والاعتماد الأكاديمي، والمشكلات الأخلاقية للعلم والثورة البيولوجية ؛ كالاستنساخ، وزراعة الأعضاء، ومنع الحمل، ومشاكل الفضاء السيبرنيتي والأقمار الاصطناعية والوسائط الإعلامية والتواصلية الجديدة والآثار الاجتماعية والأخلاقية فضلا عن المشكلات المستعصية التي تفتك بالمجتمعات العربية والإسلامية منذ زمن طويل ومنها: مشكلة الهوية والحروب الطائقية إذ تعيش مجتمعاتنا العربية اليوم حروب طائفية مستعرة في كل مكان وغير ذلك من المشكلات الحيوية الأخرى..
وهنا تزداد الحاجة، إلى المنظور التكاملي للعلوم الطبيعة والإنسانية والاجتماعية اليوم، أكثر من إي وقت مضى وذلك أثر الثورة المنهجية التي شهدها الثلث الأخير من القرن العشرين إذ أحلت النظر السوسيولوجية للعلم محل النظرة الابستمولوجية الصرفة وهذا ما أفضى إلى تغير جذري في النظرة إلى العلم بوصفه صنعة إنسانية وإبداعاً إنسانياً، ومؤسسة سوسيولوجية، وفعالية اجتماعية، ومغامرة تاريخية إلا يمكن تعيين خصائصها بمعزل عن البيئة الفيزيقية والحيوية والجغرافية والسياسية والثقافية الإنسانية العامة وهذا يعني أن مسألة، نمو العلوم وتقدمها, هي مسألة، ليست ابستمولوجية أو مهنية خالصة فحسب، بل مسألة, سوسيولوجيا حضارية ثقافية عامة، مرهونة بسياق مجتمعها المتعين وصحته وقدراته وفرصه وممكناته الواقعية والافتراضية التي من شأنها أن توفر وتؤمن البيئة الحاضنة والراعية والدافعة لنموها وازدهارها أو العكس..
ولما كان العلم بجميع أبعاده وعناصره المعرفية النظرية والمنهجية والتطبيقية والتقنية ، يعد الظاهرة الأبرز في القرن الحادي والعشرين؛ قرن العلم والثورة العلمية بامتياز ، فقد استقطب جلّ اهتمام الفلاسفة والمفكرين والعلماء ودفعهم إلى إعادة التأمل والتفكير فيه بوصفه ظاهرة جديرة بالتفكير والفهم والتفسير وذلك من منظور تكامل المعرفة العلمية. فقد ولى الزمن الذي كان ينظر الناس فيها إلى التخصصات العلمية بوصفها مجالات مستقلة ولا رابط بينها..
وكلما زاد تقارب العالم واندماجه كلما زادت الحاجة إلى تقارب العلوم وتكاملها. وهنا يأتي دور الفلسفة بوصفة نظرة كلية إلى لعالم. فمن نحن اليوم؟ وكيف نعيش الحاضر؟ وماذا سنكون غدا؟ هذا السؤال المزدوج الأبعاد والمعاني هو سؤال الفلسفة في كل عصر جديد، حيث يتشكل الواقع الإنساني من جديد .فما طبيعة العلاقة بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية؟ وكيف نفهم العلاقة التكاملية بين أنساق المعرفة العلمية في مختلف المجالات الطبيعية والثقافية.إذ لأول مرة في تاريخ المعرفة الإنسانية تتوحد العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية والتربوية في مواجهة أزمنة العالم الراهن مع جائحة كورونا كوفيد-١٩ التي مسحت الصفحة..
وقد ذهب فيلسوف العلم المعاصر ميشيل بولاني إلى تأكيد الطابع الإنساني العام للمعرفة العلمية،" فصحيح أن العلم الطبيعي يبحث في عالم فيزيقي لا شخصي، إلا أنه ذاته نشاط ذو سمة شخصية، فلا يمكن تتبع نمو المعرفة العلمية إلا كسلسلة من أفعال أشخاص معينين وإنجازاتهم وأحكامهم وكشوفهم وخيالاتهم وحدوسهم، والعلم لا يعمل في فراغ مطلق، بل يفلح أرضاً مهدتها الثقافة السائدة أو تركتها صعيد بلقعاً" كما أكد مارجوليس في كتابه, علم بغير وحدة : إصلاح ذات البين للعلوم الإنسانية والطبيعة "أن مشاريع العلم هي بصورة حاسمة إنجازات إنسانية، والصفة الجذرية للعلم بعد كل شيء أنه نشاط إنساني .. لذلك فكل العلوم هي علوم إنسانية من زاوية إنجازها الفعلي، فلا يمكن تعيين خصائصها بمعزل عن ملامح الثقافة الإنسانية والتاريخ الإنساني واللغة الإنسانية والخبرة الإنسانية والاحتياجات والاهتمامات الإنسانية..
لقد أسهمت النظريات الاجتماعية في تطور المعرفة العلمية بشكل ملحوظ، حيث أدت النظريات الكبرى، مثل الماركسية، والوظيفية، والتفاعلية الرمزية، إلى تطوير فهم أكثر شمولًا للواقع الاجتماعي. كما أدى ظهور نظريات جديدة مثل ما بعد الحداثة ونظرية الحوكمة إلى فتح آفاق جديدة في تحليل الظواهر الإنسانية فضلا عن أ لفهم العقلاني للتحديات المعاصرة.
ثمة من يرى أن وراء نهضة الشعوب الشرق آسيوية أسباب ثقافية ، وأن الفلسفات والعقائد الفكرية الشرق آسيوية مثل الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية والجيانية بما تمتلكه من منظومة قيمية إيجابية تحث على السلام والتناغم والانسجام والإيثار والتضحية والإخلاص بالعمل والنزعة الجماعية ونبذ الأنانية وقمع الشهوات والانفعالات العنفية والنزعة السلامية وحرية الذوات الفردية في ممارسة الخبرات الدينية ونبذ التعصب والتطرف والتكفير ومن ثم تعايش المذاهب والاعتقادات والطوائف والأفكار والأديان بكل سلاسة وتقدير واحترام في الدولة الواحدة اذ يوجد في الهند وحدها أكثر من ألفي طائفة دينية متعايشة.لقد أثارت نهضة الشرق الآسيوي حَفِيظة أوروبا الغربية وجعلتها تعيد التفكير من جديد في الشرق ومعناه وممكناته، فكان المدخل الثقافي في تفسير تلك الظاهر هو ما جذب الكثير من الأهتمام بعد أن تبين عدم كفاية المداخل النظرية الآخرى التي تم الرهان عليها في الغرب ، ومنها المدخل العسكري والأمني والمدخل المادي الاقتصادي ، والمدخل التعليمي التربوي وغير ذلك. في ضوء هذا المنظور يمكن تمثيل العلاقة بين العلم والثقافة بعلاقة الابن والأم،.
فالثقافة هي الرحم الحي لتخصيب وميلاد ونمو العلم، فكيفما كانت صحة الأم يكون الابن سليماً أو سقيماً. ولا تطور ولا تقدم ولا تنمية الا بمعرفة وفهم قوانين الطبيعة والتاريخ والمجتمع وحركتها ولا يكون فهمها الا بازدهار الثقافة بوصفها قوة التاريخ الإبداعية وتتعين بذلك التطور الدائم المستمر في العلوم والفنون والآداب ولا يكون ذلك الازدهار والتطور الثقافي إلا في بيئة حضارية متعافية بوصفها قوة التاريخ التنظيمية سياسة واخلاقا وتشريعا..
من المعروف أن إي فعل أو سلوك إذا ما تكرار يصير عادة وإذا ما ترسخت العادة صارت ثقافة! فلماذا لم يتحول العلم والتعليم في المجتمعات العربية الإسلامية إلى ثقافة ؟ وما الذي يفسر شيوع الخرافة والعنف والتعصب والتطرف والإرهاب بعد هذا المسار الطويل من نشوء المؤسسات العلمية العربية إذ تعد الجامعة مقوماً أساسياً من مقومات الدول العصرية، وركيزة من ركائز تطور المجتمعات البشرية وتحقيق تقدمها العلمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن كونها بيوتاً للخبرة ومعقلاً للفكر والإبداع، ومركزاً لانتقال الإنتاج والمعرفة وتطبيقها وبؤرة للتحديث والتجديد والتنوير والتغيير، وهي أهم وأخطر مؤسسة حديثة وإستراتيجية في تاريخ الحضارة الإنسانية، وذلك لإسهامها الحاسم في نهضة وازدهار مشروع الحداثة العلمية العقلانية في عموم الكرة الأرضية، وأهمية الجامعة لا تعود إلى قيمة وظائفها الأساسية الثلاث: المتمثلة في نقل المعرفة خلال وظيفة التدريس، أو في إنتاج وتطوير المعرفة وظيفة البحث العلمي أو في استخدام وتطبيق المعرفة وظيفة خدمة وتنمية المجتمع فحسب، بل وإلى كونها تعد المثل الأعلى لمؤسسات المجتمع المدني الحديث والإدارة البيروقراطية الرشيدة، وذلك بما تمتلكه من بنية تشريعية دقيقة التنظيم وإدارة فنية أكاديمية كفؤة وعالية الجودة وقيم ومعايير، وهيئة أكاديمية علمية قانونية وثقافية وأخلاقية وجمالية وحضارية وإنسانية وعقلانية شاملة..
وقد تأسست أول جامعة عربية في مصر عام 1908م بجهود أهلية ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام 1925م جامعة القاهرة حالياً، وكانت جامعة دمشق التي تأسست عام 1923م أول جامعة عربية حكومية حديثة وفي عام 1942م أنشأت جامعة الإسكندرية وفي العام ذاته تأسست جامعة القرويين في مدينة فاس المغربية، ثم تأسست جامعة الخرطوم سنة 1955م وجامعة بغداد في سنة 1957م وتأسست أول جامعة في عدن 1970م وفي عام 1971م تأسست جامعة صنعاء، وتأسست جامعة السلطان قابوس في مسقط عام 1986 وهناك ما يربوا على 700 جامعة عربية حكومية وخاصة، معظمها حديثة النشأة إذ نشأ أكثر من 80% منها بعد عام 1970م. ففي الجزائر 66 جامعة وفي المغرب 29 جامعة وفي تونس حوالي 30 جامعة ومؤسسة تعليم عالي. ففي اليمن وحدها اليوم أكثر من أربعين جامعة فضلا المعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى..
هذا التوسع الكمي في الجامعات اليمنية أفضى إلى إنتاج عشرات الآلاف من حملة الشهادات الأكاديمية من النوع الاجتماعي، ورغم ما لهذا من ملامح إيجابية عامة في شيوع أهمية الجامعة وشهادتها، إلا أنه أفضى إلى جعل الجامعات أشبه بالمدارس التقليدية التي تمنح الشهادات لغرض البحث عن وظائف عمل ممكنة...