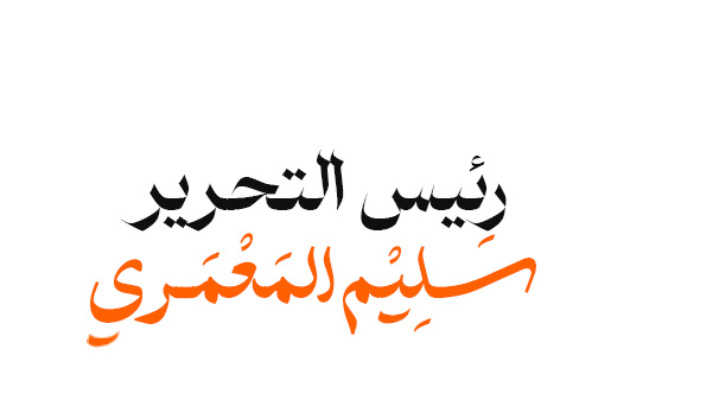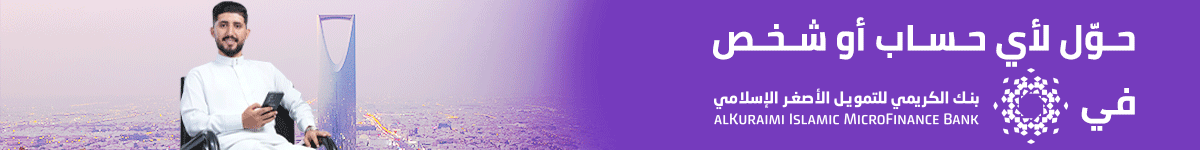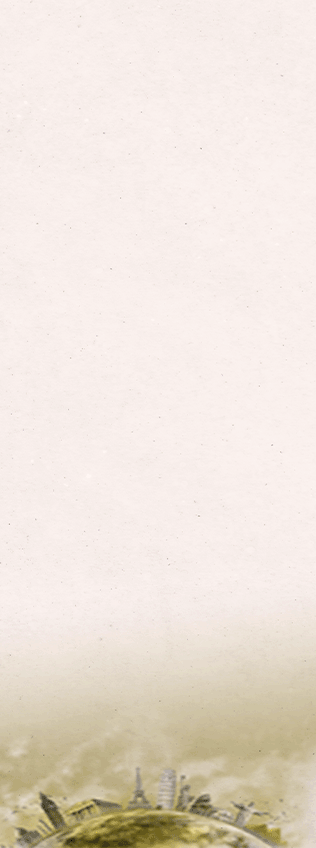خلاصة؛ النقد التاريخي والدراسات الثقافية البارحة قدمتها في الملتقي الدولي لغرفة ١٩ !!..
الكاتب / بروفيسور قاسم المحبشي ..
على مدى السنوات القليلة الماضية شهدت الدوائر الأكاديمية والثقافية والإعلامية عبر العالم ازدهار خطاب الدراسات الثقافية والنقد الثقافي بوصفه نسقا معرفيا جديدا في حقل المعرفة الإنسانية إذ أخذ يتموضع على تخوم السرديات التقليدية للآداب والعلوم الإنسانية فبدلا من الأدب والفن الرفيع حل الاهتمام بالآداب والفنون الشعبية وبدلا من دراسة المجتمعات والطبقات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية أنصرف الاهتمام إلى البحث في الجمهور والعلاقات والأنساق المتخفية وذلك بعد الأزمة النظرية والمنهجية التي واجهتها العلوم الإنسانية والاجتماعية ومازالت بإزاء تحديات وأسئلة ومشكلات لم تشهد مثيلاً لها في تاريخها الطويل، وهذا ما يشف عنه القلق المتزايد الذي أخذ ينتاب علماء الإنسانيات والاجتماع في المجتمعات الغربية، بعد أن أحسوا بعجزهم إزاء ما يشهدونه من تحولات وظواهر جديدة لا عهد لهم بها، وليس بمقدور نماذجهم المعرفية التقليدية الإحاطة بها وفهم دلالاتها. كتب عالم الاجتماع الفرنسي جوفاني بوسينو: "إذا كان من الواجب تمييز علم الاجتماع في الأربعين سنة الأخيرة بكلمة واحدة فإن )كلمة) انقلاب هي التي تفرض نفسها بالتأكيد، فمنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين بدأت الوظيفية ومعتقدات وتأكيدات أخرى تتمزق، وبدت كل التحليلات والتنبؤات المتعلقة بالواقع التاريخي الاجتماعي التي غذت تفكيرنا ووجهت بحوثنا حينذاك حشوية وخادعة، وأدى عجزنا عن تفهم وتفسير انبثاق الجديد والمختلف والمغاير والآخر... وبات وجودنا ونشاطنا من الآن فصاعد باطلاً وغير مفيد .. وبدون جدوى؛ إذ تحطمت فكرة الجماعة التي كانت تمنحنا هويتنا المهنية، ودورنا ومقاييسنا العلمية وآمالنا ومشاريعنا ... وأدركنا أن مجرى التحولات الجديدة والتغيرات السريعة قد جردتنا من كل أدواتنا وأطرنا المرجعية التقليدية. ويخلص بوسينو إلى التساؤل) :هل هو إفلاس العلوم الاجتماعية وموت علم الاجتماع وبطلان كل نماذج معرفتنا للشأن الاجتماعي؟ مجيباً: إني لا أعرف الإجابة وكل ما أعرفه أن العقل الغربي هزته أزمة عميقة، يصعب تحديد طبيعتها وعمقها ومداها ونتائجها"( جيوفاني بوسينو ، نقد المعرفة في علم الاجتماع ، ترجمة محمد عزب صاصيلا ، المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت ، 1995،ط1، ص18) وفي السياق ذاته جاءت صرخة بول فيين؛ إذ كتب تحت عنوان فرعي،) توعك السوسيولوجيا) قائلاً " ليس سراً على أحد أن السوسيولوجيا تعيش اليوم متوعكة، وأن أفضل رجالها بل ومعظمهم لا يأخذون على محمل الجد إلا العمل الامبريقي التجريبي… وبإيجاز فالسوسيولوجيا ليست ككلمة إلا جناساً (اتفاق الحروف واختلاف المعنى ..(فليست السوسيولوجيا بالتعريف فرعاً علمياً متخصصاً، فرعاً متطوراً ، ولا وجود لاستمراريتها إلا بواسطة اسمها الذي يقيم صلة لفظية بحتة بين أنشطة عقلية لا صلة بينها" (بول فيين ، أزمة المعرفة التاريخية ، فوكو و ثورة في المنهج ترجمة ، إبراهيم فتحي، دار الفكر للدراسات القاهرة، 1993،ط1، ص194 ) في الواقع لقد طالت الأزمة أنساق العلوم الإنسانية الغربية كلها، وانتشرت كالنار في الهشيم في مختلف الدوائر الفكرية والأكاديمية الأورأمريكية، فعلى صعيد الدراسات التاريخية كتب المؤرخ الإنجليزي جفري باراكلاف من جامعة أكسفورد تحت تأثير الإحساس العميق بالأزمة: "إننا مهاجمون بإحساس من عدم الثقة، بسبب شعورنا بأننا نقف على عتبة عصر جديد لا تزودنا فيه تجاربنا السابقة بدليل أمين لسلوك دروبه، وإن أحد نتائج هذا الموقف الجديد هو أن التاريخ ذاته يفقد - إن لم يكن قد فقد - سلطته التقليدية ولم يعد بمقدوره تزويدنا بخبرات سابقة في مواجهة المشكلات الجديدة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ آدم حتى اليوم"( تيدور هيمور، تأملات حول التاريخ والمؤرخين عرض وتحليل مصطفى العبادي، مجلة عالم الفكر الكويتية - المجلد العشرون.. العدد 1 يونيو 1989،ص260) وقد بلغ هذا الموقف المتشكك بلا جدوى التاريخ والمعرفة التاريخية عند المؤرخ الأمريكي دافيد رونالد، من جامعة هارفارد، حد الاستفزاز والتحدي في كتابه، (تاريخنا بلا أهمية) إذ أعلن "أن التاريخ يظهر مقدار ضعفنا في مواجهة الحاضر وأننا لا نتعلم من أخطاء الماضي، وما أقل تأثيرنا في ما ينزل بنا من أحداث، وما أشد عجزنا في قبضة قوى أساسية هي التي تشكل الوجود الإنساني" (تيدور هيمور،المرجع السابق ص 261) ويمكننا تتبع هذا الإحساس القلق بحالة الأزمة عند عدد واسع من علماء الإنسانيات من مختلف الأنساق المعرفية، فهذا عالِم الاجتماع التربوي مالكهولم تويلز يقر بذلك حيث يقول: "إننا نعيش في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية وتتغير فيه المعارف بسرعة مضطردة، بحيث غالبا ما تصبح فيه الكتب قديمة قبل خروجها من المطبعة، وبات من الضروري إعادة النظر في استراتيجيات التربية والتعليم وأهدافها بما يتواكب مع تلك المعطيات الجديدة"( اوليفيه ربول، فلسفة التربية، ترجمة، جيهان نعمان، دار عويدات، بيروت _ باريس، 1986،ط3، ص30) تكشف تلك النصوص طبيعة الأزمة وقوة أثرها الصادم عند علماء الإنسانيات الغربيين وكيفية تعاملهم وفهمهم لها؛ وبغض النظر عن تأويلات الأزمة، يهمنا التأكيد أن ثمة اتفاقًا بين معظم الفلاسفة والعلماء على أن المجتمع الإنساني الراهن يعيش لحظة تحول سريعة ومضطربة تصيب الإنسان بالذهول وتتحدى قدراته على الفهم والحكم والتمييز "إذ سرعان ما تأتكل الكلمات في محاولة التعبير عن هذا العالم المنبثق حيث الحركة هي القانون والرجوع إلى الماضي لا يسعف كثيراً في فهم هذا الزمان، فهناك كثير من المستجدات التي توهن العزم على الاستعانة بالمماثلة وأن المشكلات التي تراكمت في أواخر القرن العشرين جعلت العالم يبدو للإنسان وكأنه تيه" (جورج بالانديبة المرجع السابق، ص3) وسط هذه الأزمة العاصفة وقف علماء الإنسانيات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التشاؤم والقنوط واليأس والعجز, وإما التفاؤل والتفكير والمبادرة باتخاذ موقف نقدي جذري من كل شيء؛ نقد الذات ونقد التصورات ونقد التاريخ والتراث والمجتمع والحياة ونقد نظرياتهم ومناهجهم وأدواتهم وتصحيحها في ضوء المتغيرات وما تحمله من معطيات وممكنات إبستيمولوجية جديدة ونقد الثقافة. وهذا ما تم فعلاً؛ إذ مثلّت سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لحظة تحول حرجة للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مواجهة السؤال الجوهري: "كيف يمكن جعل مرحلتنا المفصلية بين مجتمع الأمس الآخذ بالزوال وبين المجتمع الآخذ في الانبثاق قابلة للتعقل والإدراك؟"( يان سبورك، المرجع السابق، ص12).
- هنا ولدت الدراسات الثقافية من قلب الأزمة وتجاوزا لها وسوف نكرس بحثنا لرصد الأسس الفلسفية لنمو وازدهار الدراسات الثقافية ونعني بالأسس الثقافية بالأسس الفكرية نعني تلك المعتقدات والأفكار والنظريات الكلية الميتافيزيقية التي يعتنقها الناس شعورياً ولا شعورياً عن أنفسهم وعن الكون والحياة والمجتمع. وهي منظورات كلية يسلم بها جماعة من الناس ويعدونها بديهيات ومرجعيات لا تقبل الجدل والتشكيك أوهي إذا استخدمنا تعبير فرنسوا ليوتار حكايات كبرى ومرجعيات أيديولوجية للشعور والسلوك والعمل. أو هي الباراديمات أو النماذج المحتذى بها للنظر والسلوك والعمل تشبه المعتقدات والقناعات الأيديولوجية.
لا ريب إن الدراسات الثقافية بوصفها مجالا معرفيا نقديا معرفيا تكامليا يجمع بين طيف واسع من الأنساق المنهجية والنظرية الأكاديمية؛ الفلسفة, الانثريولوحيا الثقافية والاستشراق والنقد والثقافي والتحليل النفسي وسوسيولوجيا المعرفة واللسانيات ومابعد الكولونيالية والدراسات النسوية وأخلاقيات العلم والإعلام الجديد جاءت استجابة لظهور أنماط جديدة من الظواهر والمشكلات الإنسانية والاجتماعية الجديدة، وسرعة تحولها إلى مشكلات عالمية، كمشكلة سباق التسلح والحروب والأمن والسلام الدوليين، ومشكلات البيئة الأرضية والأوزون، وصدام وحوار الحضارات، ومشاكل الاقتصاد والتجارة والمال والأعمال العابرة للقارات. ومشاكل الفقر والصحة والمرض، ومشكلة التطرف والإرهاب والعنف، ومشاكل الهويات الطائفية والتعددية الثقافية، والأقليات والتمييز والتعصب والاستبعاد الاجتماعي، والهجرة غير الشرعية والاندماج، والمخدرات ومشكل الفساد والبطالة و والحركات الاجتماعية والثورات، وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب، وكل ما يتصل بالحقوق المدنية، ومشاكل التربية والتعليم والجودة والاعتماد الأكاديمي، ومشاكل السياسة والنظم السياسية والعدالة والحرية والديمقراطية والمجتمع المدني والعدالة الانتقالية. والمشكلات الأخلاقية للعلم؛ كالاستنساخ، وزراعة الأعضاء، ومنع الحمل، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومشاكل الفضاء السيبرنيتي والأقمار الاصطناعية والتنافس التقني ألمعلوماتي والإعلام الجديد ووسائط التواصل الاجتماعي كل تلك الأحداث التاريخية لاسيما الحربين العالميتين الأولى والثانية والمتغيرات التقنية والتحولات الاجتماعية التي طالت كل مناحي الحياة الإنسانية والاجتماعية للعالم الراهن استدعت ظهور نمط جديد من المحاولات النظرية والمنهجية في النظر إلى التاريخ وقواه الفاعلة وفهمها ومن ذلك ازدهار تيار التاريخ الجديد بوصفه محاولة " لدراسة وفهم كل شيء فعله الإنسان أو فكر فيه أو أمل فيه أو حلم به منذ تفتق وعيه البشري على كوكبنا الأرضي " وعلى الرغم من إن حركة التاريخ الجديد قد انطلقت من الولايات المتحدة ومنذ عام 1912 .فأنجبت الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. ازدهرت مدرسة التاريخ الجديد بوصفها أنضج ثمار مناهج النقد التاريخي منذ السرد الأسطوري واللاهوتي مرورا بالرومانطيقية والوضعية والتأملية الماركسية والإنسانية والنقدية الجديدة المتمثلة بالتاريخ الجديد الذي جرى ترسيمه بمجلة الحويات الفرنسية سنة 1929 تحت عنوان "حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" بإشراف هيئة مكونة من مارك بلوك ولوسيان فيبر رئيسا للتحرير، فضلا عن ثلة من الكتاب والباحثين الذين ينتمون إلى تخصصات متعددة كالجغرافيا وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس وغيرها من العلوم- أفقا منهجيا ثوريا في الكتابة التاريخية بأفق أكثر شمولية وسعة وعمقا؛ تاريخ متحرر من تابو الوثائق وما تفرضه من قيود صارمة تاريخ ينظر إلى ما فعله وأنتجه الإنسان في مسار حياته بذات القدر من الأهمية ( اللغة، واللهجات، والأدوات والعلامات، والآثار ، ونظم الزراعة والأساور والقلائد، والحكم والأمثال والآداب والحكايات والأفكار والذهنيات والقيم والعادات وكل شيء يمكن الحصول عليه الواقع أو الذكريات) وهذا ما جعل التاريخ. منفتحاً على كل العلوم ومكتشفاتها كالجغرافية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس والانثربولوجيا والفلسفة والأدب والفنون وذلك انطلاقا من النظر إلى المجتمع بوصفه وحدة عضوية، لا يمكن تجزئته إلى قطع مستقلة تدرس كل واحدة منها بمعزل عن الأنساق الأخرى فالكل هو أكبر من مجموع أجزاءه دائما. في هذا السياق الأوسع يمننا النظر إلى العلاقة التكاملية بين النقد التاريخي والدراسات الثقافية التي أخذت تتموضع على تخوم السرديات التقليدية للآداب والعلوم الإنسانية فبدلا من الأدب والفن الرفيع حل الاهتمام بالآداب الشعبي والفنون الشعبية وبدلا نقد النص والخطاب حل نقد السياقات والعلاقات وبدلا من دراسة المجتمعات والطبقات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية أنصرف الاهتمام إلى البحث في الجمهور والذهنيات والسرديات والعلاقات والأنساق المتخفية
في الواقع لم تولد الدراسات الثقافية بوصفها تخصصًا أكاديميًا مكتمل المعالم بقدر ما نشأت كموقف نقدي من العالم. فهي أقرب إلى “وعي يقظ” بالتاريخ كما يتسرّب في تفاصيل الحياة اليومية: اللغة، العادات، الإعلام، الذوق، والهويات المتحوّلة. لذلك، فإن أسسها الفلسفية ليست مجرد أدوات تحليل، بل هي منظومة قيمية ترى في الثقافة ساحة صراع ومعنى، لا مرآة خاملة للواقع.إذ لم يكن ازدهار هذا الحقل من الدراسات حدثًا معزولًا عن سياقه التاريخي الثقافي؛ بل جاء نتيجة تشكّل تاريخي شهدته المجتمعات الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ومن تلك المتغيرات يمكن الاشارة إلى :
اولا: التغير في البنية الاقتصادية والصعود الجديد للطبقة العاملة إلى بحث جديد عن فهم الثقافة الشعبية، لا بوصفها “دونية ليست مهمة كما كان التركيز سابقا على الثقافة الرفيعة والأدب الرفيع”، بل كحيّز يعكس صراعًا اجتماعيًا حقيقيًا.
ثانيا: التوسع في مجال الإعلام الجديد ومنها التلفزيون والراديو والصحافة الشعبية خلق حاجة ملحّة لأدوات نقدية تتجاوز الدراسات الأدبية التقليدية، وتفهم علاقة الصورة بالسلطة.
ثالثا:
شهدت بريطانيا في الستينيات والسبعينيات موجة من الحركات الطلابية والنسوية والعرقية، ما جعل سؤال الهوية والمساواة جزءًا من الأجندة الثقافية والسياسية حيث وجدت الجامعات البريطانية نفسها أمام توجهات جديدة تكسر الحواجز بين التخصصات. الدراسات الثقافية ازدهرت لأنها لم تعترف أصلًا بتلك الحدود، بل خلخلتها. ورغم إن بريطانيا لم تكون مرتعا لتوجهات النقدية كما كانت المانيا وفرنسا ولا زالت ومع ذلك نشاءت البذرة شكّلت البذرة الأولى للدراسات الثقافة والنقد الثقافي في بريطانيا خلال ستينيات القرن العشرين، حين تأسّس “مركز الدراسات الثقافية المعاصرة” في جامعة برمنغهام (CCCS) على يد كلا من :
• ريتشارد هوغارت Richard Hoggart: الذي رأى أنّ الثقافة ليست حكرًا على النخب، بل تتجلى في التجارب الشعبية اليومية، بما تحمله من مقاومة صامتة وصراع مع رسائل الإعلام والصناعة الثقافية.
• ريموند ويليامز Raymond Williams: صاحب المشروع الأشمل لفهم الثقافة كبنية معنى حيّة، تتحرك مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كان يرى أنّ التاريخ ليس ما يُكتب في الكتب، بل ما تعيشه الناس في لغتهم وتجاربهم.
• ستيوارت هول Stuart Hall: المفكر الذي أعطى للمجال قوته التحليلية والسياسية. قدّم أدوات لفهم التمثيل Representation، والهوية، والسلطة، وكيف تُنتج الثقافة أشكال الهيمنة والمقاومة. مع هؤلاء الثلاثة تشكلت نواة اتجاه نقدي يتجاوز حدود الأدب والعلوم الاجتماعية، ويعيد التفكير في الثقافة كحقل ديناميكي تتصارع فيه الطبقات، وتتفاعل فيه الهويات، وتُعاد صياغة المعنى.ويمكننا تتبع الأسس الفلسفة الفكرية للدراسات الثقافية في المنطلقات الثقافية التالية:
1. الماركسية الثقافية ونقد الهيمنة
استند الجيل المؤسس بقوة إلى التراث الماركسي، خاصة عبر أنطونيو غرامشي، الذي قدّم مفهوم الهيمنة بوصفها “قيادة ثقافية وأخلاقية” تمارسها الطبقة المسيطرة، لا قسرًا بل إقناعًا. هذا المفهوم سمح لهول ورفاقه بقراءة الثقافة كحقل لا ينفصل عن الاقتصاد السياسي، لكنه لا يُختزل فيه.
٢. البنيوية وما بعد البنيوية
كان تأثير البنيوية الفرنسية واضحًا، خاصة عبر رولان بارت وكلود ليفي-شتراوس، ثم نقدها ما بعد البنيوي؛ فالمعنى لم يعد ثابتًا، بل يُنتَج داخل شبكة من الخطابات. هذا ما سيقود ستيوارت هول إلى تحليل الإعلام ليس كمجرّد وسيط، بل كجهاز لإنتاج تمثيلات تصوغ وعي الجمهور.
٣. الفلسفة الأخلاقية الجديدة
لم تُصغ الدراسات الثقافية نفسها ضمن إطار معياري واضح، لكنها حملت منذ بدايتها حساسية أخلاقية تجاه المهمّشين: المرأة، العامل، الأقليات العرقية، المهاجر. هنا يُفهم الطابع الأخلاقي غير المعلن للمجال، وكأنه صوت موجّه نحو مساءلة القوة أينما تمركزت.
إذا كانت الدراسات الثقافية قد نشأت كقراءة نقدية للحداثة الصناعية والإعلام الجماهيري، فإن التحدي اليوم هو إعادة التفكير في أدواتها أمام عالم تغيّر جذريًا بفعل الرقمية والذكاء الاصطناعي. هل ما زالت مفاهيم مثل “الهيمنة” و”التمثيل” كافية لفهم ثقافة مُشتتة، بلا مركز، تصنعها منصات لا مرئية وخوارزميات تتسلل إلى سلوك الإنسان قبل وعيه؟
هذا السؤال يعيد الدراسات الثقافية إلى جذورها الفلسفية الأولى: مساءلة المعنى، وفهم السلطة، والبحث عن الإنسان داخل شبكة من المؤسسات والقوى التي تعيد تشكيل نظرته إلى نفسه والعالم.
وحينما يكتب مالو ( أن التاريخ هو أن نترك ندبة في الأرض) أو يكتب الأمريكي " دافيد رونالد" من جامعة هارفارد،( تاريخنا بلا أهمية) 1977م أو حينما يعلن المؤرخ البريطاني " ج. هـ. بلومب " في كتابه " حيرة المؤرخ" عام 1964م " ليس للتاريخ معنى أو فاعلية أو رجاء، فقد اندثرت فكرة الرقي والتقدم الصاعد بين المشتغلين بالتاريخ، فــ 90% منهم يرون أن العمل الذي يمارسونه لا معنى له على الإطلاق" أو يكتب المؤرخ الإنجليزي المشهور " جفري باراكلاف" من جامعة اكسفورد، تحت تأثير الإحساس العميق بالأزمة " إننا مهاجمون بإحساس من عدم الثقة بسبب شعورنا بأننا نقف على عتبة عصر جديد لا تزودنا فيه تجاربنا السابقة بدليل أمين لسلوك دروبه، وان أحد نتائج هذا الموقف الجديد هو أن التاريخ ذاته يفقد، إن لم يكن قد فقد سلطته التقليدية ولم يعد بمقدوره تزويدنا بخبرات سابقة في مواجهة المشكلات الجديدة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ آدم حتى اليوم" ١٩٧٠م وحينما يكتب فوكوياما نهاية التاريخ والإنسان الأخير عام ١٩٩٠ لمن المؤكد إن ثمة أزمة عاصفة في علاقة الإنسان بالتاريخ ومناهجه. أمّا اليوم، في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فنحن في قلب انعطافة لا تقلّ راديكالية عمّا سبقها. الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لا تغيّران أدوات المؤرخ فحسب، بل تغيّران طبيعة التاريخ نفسه. فالماضي لم يعد محصورًا في وثيقة أو ذاكرة، بل أصبح بنية من البيانات الهائلة تُقرأ بالخوارزميات وتُعاد صياغتها بالتعلّم العميق. المؤرخ أصبح يجاور عالم البيانات، والذاكرة الإنسانية باتت رقميّة: تُفهرس، تُفلتر، وتُعاد هندستها في لحظة.
هنا يتشكّل السؤال الفلسفي الحادّ:
هل نحن أمام مدرسة تاريخية جديدة—مدرسة التاريخ الخوارزمي—حيث يصبح الماضي قابلًا للحوسبة؟ أم أنّ الذكاء الاصطناعي يهدّد بتحويل التاريخ إلى محاكاة بلا روح، تفقد فيها التجربة الإنسانية قدرتها على إنتاج المعنى؟...