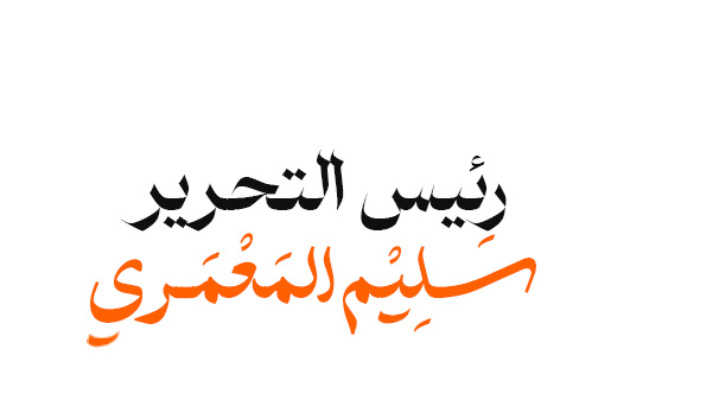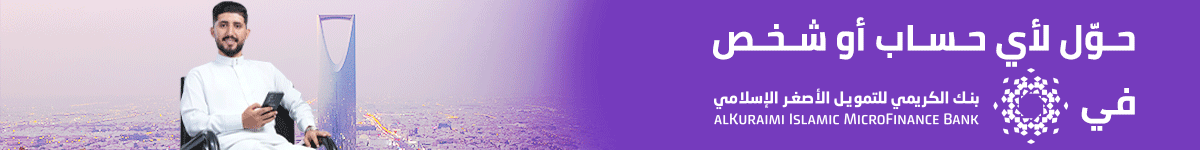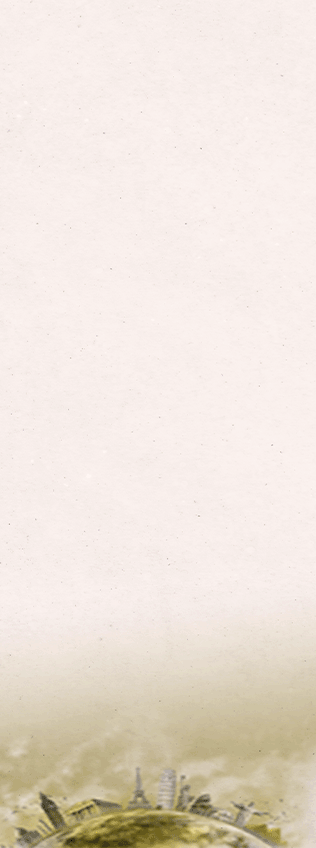السياسات المالية والنقدية، بين تحديات الأزمة وإمكانات التدخل
د/ علي ناصر سليمان الزامكي
أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن
مقدمة
تشهد بلادنا واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخها الحديث، نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي وتراجع الموارد العامة، ورغم التحركات المحدودة للبنك المركزي والحكومة في ضبط سعر الصرف، إلا أن التحديات الكبرى تظل قائمة في ما يتعلق بقدرة الدولة على صرف المرتبات، وإدارة الموارد النقدية، والحفاظ على استقرار السوق المحلي، وتتطلب قراءة المشهد الراهن مقاربة علمية تجمع بين تحليل الأدوات المالية والنقدية المتاحة، وقضية الدولار الجمركي وقياس مستوى الشمول المالي، ورصد السياسات الممكنة للخروج من الأزمة.
اولاً: المشكلة التي يعالجها المقال،
كيف يمكن للسياسات المالية والنقدية في اليمن أن تواجه الأزمة الراهنة المتمثلة في:
1. ضعف القدرة على صرف المرتبات بانتظام.
2. تقلبات سعر الصرف وانعكاساتها على الأسعار.
3. محدودية موارد الدولة وعدم استقرار الإيرادات.
4. ضعف الشمول المالي وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية.
ثانياً: أهمية المقال
- علميًا:إثراء النقاش النظري والفكري حول الاقتصاد من منظور السياسات المالية والنقدية.
- عمليًا: تقديم إطار استرشادي لصنّاع القرار لتجاوز الأزمة الراهنة.
ثالثاً: أهداف المقال
1. تحليل قدرة الموارد المركزية وإمكانية صرف المرتبات.
2. قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.
3. تحليل اثر تحركات أسعار الصرف على الأسعار.
4. استعراض السياسة المالية وإدارة السيولة في مواجهة التحديات الراهنة.
5. تحليل توجه الدولة والحكومة لتحرير ورفع الدولار الجمركي.
6. تقييم الشمول المالي والسياسات المالية والنقدية.
7. تحديد الأدوار الانية المطلوبة من السياسة المالية والنقدية.
8. صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة.
ثالثاً: المنهجية التي يعتمد عليها المقال
- المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي: لتوصيف الواقع المالي والنقدي.
- التحليل النظري: بالاستناد إلى أدبيات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية.
رابعاً: الإطار النظري للمقال:
1. السياسة المالية: تعرف بأنها "مجموعة الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
2. السياسة النقدية: تعرف بأنها "مجموعة الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للتأثير في عرض النقود وأسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملة وتحقيق النمو الاقتصادي.
3. الشمول المالي: يعني "إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبخاصة الفئات المهمشة والفقيرة بشكل عادل وبتكلفة مناسبة.
خامساً: عرض وتحليل السياسة المالية والنقدية بين تحديات الأزمة وإمكانات التدخل.
الهدف الأول: الموارد المركزية وإمكانية صرف المرتبات:
1- الإشكالية: قدرة البنك المركزي على صرف المرتبات للجهاز الإداري للدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود موارد سيادية مركزية (مثل عائدات النفط والغاز، الإيرادات الجمركية والضريبية)، وحالياً كما هو معلوم توقفت معظم الصادرات النفطية منذ أواخر 2022، ما أدى إلى انخفاض كبير في الموارد من العملة الأجنبية، والإيرادات المحلية تُعد غير كافية لتغطية فاتورة المرتبات لثلاثة أشهر متتالية دون اللجوء إلى أدوات تمويل إضافية.
2- الواقع الحالي: لا يمكن للبنك المركزي صرف المرتبات بشكل منتظم ودون إعلان مزادات لبيع الدولار ، إلا إذا توفرت موارد مركزية مشتركة (منح، دعم خارجي، أو موارد محلية سيادية).
3- الاستنتاج: الموارد المتاحة حاليًا غير كافية إلا بشكل جزئي، مما يجعل الصرف مرتبطًا إما بالدعم الخارجي (وديعة بنكية لدعم الموازنة) وبالتالي إعلان مزادات بيع الدولار أو بالسيطرة على موارد الإيرادات السيادية الأخرى (جمارك، ضرائب ).
الهدف الثاني: قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.
1- الآلية: التدخل عادة يتم عبر ضخ الدولار في السوق للحفاظ على التوازن السعري.
2- الوضع الراهن: قدرة البنك محدودة نظرًا لشح الاحتياطيات، والاعتماد على المنح (مثل الوديعة السعودية أو دعم المنظمات الدولية) هو المصدر الرئيسي للتدخل من خلال مزادات بيع الدولار لصرف المرتبات، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم ترشيد الاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية وتمويلها عبر الجهاز المصرفي.
3- التحليل: التدخلات الأخيرة ساعدت في الحد من الانهيار الكبير للريال، لكن أثرها محدود ومؤقت، ولا يمثل سياسة نقدية مستدامة، فلابد بعد نجاح القبضة الرقابية للبنك المركزي أن تتم إصلاحات هيكلية لإنجاح أدوات السياسة النقدية بشكل مستدام
الهدف الثالث: أثر تحركات الصرف على الأسعار
• رغم التذبذبات في سعر الصرف، إلا أن أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والخدمات لم تتراجع بنفس مستوى التراجع بسعر الصرف، وذلك لعدة أسباب:
- تسعير التجار بالهامش الأعلى كاحتياط ضد تقلبات الصرف.
- الاعتماد على المخزون المستورد بأسعار سابقة.
- ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
الهدف الرابع: السياسة المالية وإدارة السيولة:
- السياسة المالية المتبعة حاليا في بلادنا تسعى إلى الحفاظ على مستوى معقول من السيولة وضبط النفقات التشغيلية، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في محدودية الإيرادات واعتماد الإنفاق العام على التمويل بالعجز، الحاجة قائمة لضبط الكتلة النقدية المحلية لتفادي موجات تضخمية.
الهدف الخامس: تقييم سعر صرف الدولار الجمركي:
1- توجه الدولة والحكومي لتحريره أو رفعه: يهدف لزيادة الإيرادات الجمركية وتوحيد سعر الصرف.
2- المستفيد: التجار على المدى القصير.
3- الأثر الاجتماعي: رفع الدولار الجمركي سينعكس على أسعار السلع الأساسية ويزيد الضغط على المستهلكين.
4- التحليل العلمي: قرار رفع الدولار الجمركي يجب أن يكون تدريجيًا وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بحيث لا يكون هناك أثر على أسعار السلع الأساسية ومصحوبًا بشبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات الفقيرة.
الهدف السادس: الشمول المالي والسياسات المالية والنقدية:
1- الشمول المالي: لا يزال في بداياته، إذ لا يتجاوز 20% من السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية، مما يحد من فعالية السياسة النقدية.
2- السياسة المالية: ما زالت تركز على تغطية العجز والمحافظة على السيولة دون إصلاح جذري للنفقات والإيرادات.
3- التحديات:
- ضعف التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
- محدودية السيطرة على الكتلة النقدية المحلية.
- ارتفاع معدلات التضخم (المقنع) بسبب أسعار الغذاء والوقود.
الهدف السابع الأدوار الآنية المطلوبة من السياسة المالية والنقدية
1. على المستوى المالي ( السياسة المالية ):
- توسيع القاعدة الإيرادية (ضرائب، جمارك، إعادة تفعيل صادرات النفط والغاز).
- ضبط وترشيد الإنفاق العام.
- تحسين إدارة الدين المحلي.
2. على المستوى النقدي ( السياسة النقدية):
- تعزيز الشفافية في مزادات بيع الدولار.
- ضبط الكتلة النقدية ومنع الطباعة غير المغطاة.
- تقوية الرقابة على البنوك وشركات الصرافة.
الهدف الثامن: صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة
1. قصيرة الأجل (6 – 12 شهر):
- تفعيل أدوات التدخل المباشر في السوق النقدية.
- الحصول على دعم خارجي مشروط بالإصلاحات.
- اعتماد سياسة جمركية مرنة مع رقابة على الأسعار.
2. متوسطة الأجل (1 – 3 سنوات):
- توحيد السياسة النقدية وإعادة هيكلة البنك المركزي.
- تطوير النظام الضريبي والجمركي بما يوسع الإيرادات غير النفطية.
- إطلاق برامج للشمول المالي الرقمي.
3. طويلة الأجل (3 – 5 سنوات):
- إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي.
- استثمار الموارد الطبيعية (نفط، غاز، موانئ) كمرتكز رئيسي للاستقرار المالي.
- إصلاح شامل للسياسة الاقتصادية بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية.
كلمة أخيرة:إن قدرة البنك المركزي والحكومة على مواجهة الأزمة الراهنة مرهونة بمدى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وإرادة حقيقية في ضبط الإنفاق وتوسيع الإيرادات. فالتدخلات الجزئية عبر المزادات أو الدعم الخارجي تبقى مؤقتة، بينما المطلوب هو استراتيجية وطنية متكاملة تؤسس لخارطة طريق اقتصادية ومالية قادرة على استعادة الثقة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم الانطلاق نحو التنمية المستدامة.