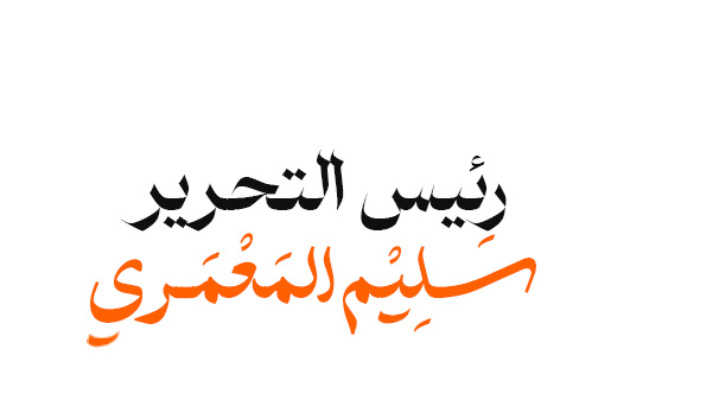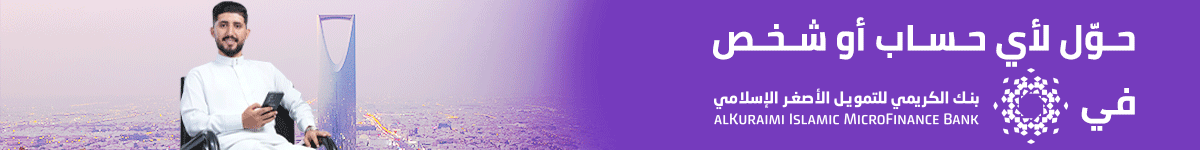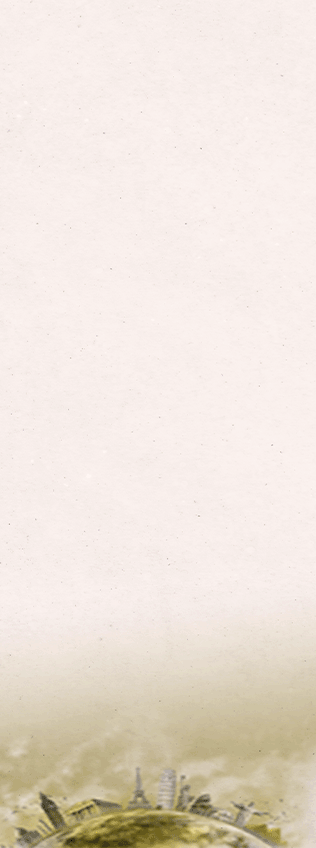بروفيسور قاسم المحبشي يكتب : في دنهاخ الحضارة الهولندية جمعتنا الثقافة ضد العنصرية...

منبر الاخبار / خاص
المنبر الثقافي / بروفيسور قاسم المحبشي ...
بدعوة كريمة من رئيس مهرجان بلاد الرافدين للشعر، الأستاذ، محمد الأمين الكرخي، سنحت لي لزيارة دنهاخ؛ أجمل مدينة بحرية وأكبرها في هولندا. بعد إمستردام وهي الملاذ الأخير للفيلسوف باروخ إسبينوزا بعد قرار طرده من المجتمع اليهودي، المسمى بـ”חרם” أو “herem” بإمستردام عام 1670م وذلك بسبب موقفه الفكري الإنساني ضد العنصرية اللاهوتية اليهودية. وأنا في طريق إلى مهرجان ميزوبوتاميا الدولي للشعر؛ ضد العنصرية في مدينة العدالة والسلام الباذخة السحر والجمال، درة بحر الشمال في دورته الثامنة بتاريخ 6-7 سبتمبر٢٠٢٥م تذكرت قول حكيم هولندا، إسبينوزا في إن ( أكثر الاشياء قربا منّا وحميمية بالنسبة لنا هي اكثر بعدا عن انتباهنا) نعم الاندماج مع بعض عاداتنا الحياة يجعلها بعيدة عن تأملاتنا ولهذا تكون حاجتنا مسألة للفلسفة لكي نرى معنى المساعي التي نمارسها كل يوم في حياتنا بحسب. فماذا يعني مهرجان بلاد الرافدين للشعر ضد العنصرية؟ بالنسبة لي يعد هذا حدثا بالغة الأهمية المعنى والدلالة إذ وجدت فيه محكا حيا لاختبار فرضية العلاقة بين قوى التاريخ الثلاثة ( الحضارة والمدينة والثقافة ووظائفها)
فما الذي يجعل الفلسطيني والعراقي والمصري واليمني والسوري والسوداني والمغربي والليبي يغادر وطنه بحثا عن ملاذ آمن؟ فوجد في بلد إسبينوزا ملاذه الحضاري الراقي؟ ربما اتينا إلى هنا كما أتى قبلنا الفيلسوف باروخ إسبينوزا بذات الدافع وانا اختلاف الوقائع. وانا اعرف ماذا يعني السفر والهجرة عن العراقيين أو المصرين بالذات إذ تعد الهجرة بالنسبة لهما حدث بالغة القسوة والوجع إذ هي اغتراب المهاجر عن أهله وذويه والعيش بعيدًا عنهم ربما لسنوات طويلة، وهذا من أقسى أنواع الحرمان بالنسبة للمهاجر؛ حرمان مزدوج ؛ حرمان المهاجر الابن من العيش مع والديه وحرمانهم منه، وحرمان المهاجر الزوج من العيش مع شريكة حياته وحرمانها منه، وحرمان المهاجر الأب من رعاية أطفاله وتربيتهم وحرمانهم منه، وحرمان الطالب الذي اضطر للهجرة من مواصلة تعليمه في وطنه وضياع مستقبله وعدم تحقيق أمنياته وطموحاته... إلخ فكم هم أولئك المهاجرون الذين قضوا نحبهم في مواطن الاغتراب؟ وكم هم الذين عادوا بعد أن أكلت الغربة زهرة شبابهم؟ وكم هنّ الزوجات اللاتي حرمن من العيش بأحضان أزواجهن لمدد زمنية طويلة، وكم هم أولئك الأطفال الذين حرموا من العيش مع آبائهم وفقدوا حنانهم لفترات طويلة من غيابهم. نعم الغربة ليست سهلة بالنسبة لمن جربها، إذ يعاني المهاجر في غربته أقسى أنواع المرارات والحسرات، فلا أحد يرحمه أبدًا، إذ عليه التكيف والعيش في وسط مجتمع جديد غريب لا يعرف أحدا فيه ولا أحد يعرفه أو يشفق أو يحن عليه في لحظات ضعفه أو مرضه. وقد استمعت إلى حكايات من قدماء المهاجرين العرب تدمي القلب. وانا استمع إلى الشعراء والشاعرات الذين يتلون قصائدهم في منصة المهرجان من العراق ومصر والسودان وأفريقيا جاءوا من مختلف من اسبانيا وأستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا .الخ يتلون قصائدهم بلغات عربية وأجنبية متعددة. قفز السؤال القلق إلى ذهني؛ ما الذي دفع بأناس ينتمون إلى موطن أقدم حضارات العالم لمغادرة بلدناهم والبحث عن ملاذ آمن؟ اقصد البحث عن حماية دائمة وحقوق طبيعية ومدينة محمية وعدالة وحرية كرامة وأمن وأمان وسلام وتنمية واستقرار وتلك هي وظيفة الحضارة بوصفها القوة التنظيمية في التاريخ ( سياسة وتشريعا وأخلاقا) وبهذا تكون الحضارة ووظيفتها النظام السياسي الذي يحفظ ويصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية؛ حق الحياة والعمل والحرية والفكر والاعتقاد والتعبير فضلا عن الحقوق المدنية المكفولة في إطار القانون سيد الجميع فاذا سقطت هذه القوة التنظيمية في التاريخ تسود الفوضى ويتمزق شمل المجتمع ويذهب كل من يستطيع الاغتراب للبحث عن ملاذات آمنة للعيش والاستقرار والحضارة لا غيرها هي التي جعلت من الهجرة بوصفها انتقال الكائنات من مكان إلى مكان أخر عملية ممكنة؟ تمثل ذلك الإمكان بوجود دول وشعوب في هذا العالم تستقبل المهاجرين واللاجئين وتمنحهم الحماية والحقوقية الطبيعية والمدنية وتعاملهم باحترام وتقدير بدون تمييز من اي نوع كان. هنا يمكن فهم الفرق الجوهري بين الحضارة والثقافة. أما الثقافة بوصفها القوة الإبداعية في التاريخ ( علما وادبا وفنا) فهي تبق مع الناس حيثما حلوا أو ارتحلوا بوصفها ما يبق بعد خراب دولهم وحضارتهم. فحينما يفقد الناس أوطانهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تبقى الثقافة هي من تحملهم ويحملونها في حلهم وترحالهم بمثابة وطنهم البديل. اقصد الثقافة بالمعنى الأنثربولوجي بوصفها نسقا من الاستعدادات المُكتسبة باللغة والتربية والممارسة الاجتماعية التي تحدد سلوك الفرد ونظرته إلى نفسه وإلى الأخرين والحياة و الكون، وهو أشبه ما يكون بطبع الفرد أو بالعقلية التي تسود في الجماعة، لتشكل منطق رؤيتها للكون والعالم. ووفقاً لهذا التصور، يعد «الهابيتوس» جوهر الشخصية والبنية الذهنية المولدة للسلوك والنظر والعمل، وهو في جوهره نتاج لعملية استبطان مستمرة ودائمة لشروط الحياة ومعطياتها عبر مختلف مراحل لوجود، بالنسبة للفرد والمجتمع. بها يستحضرون أطياف أوطانهم الحبيبة وعلى أجنحتها يحلقون في الفضاءات الرحيبة، فضلا عن أن الثقافة هي النافذة الممكنة للتواصل والتعارف والتفاهم والحوار في هذا الكوكب الإنساني الذي بات شديد التقارب والانكماش. والتراث هو محور كل ثقافة ومعينها الذي لا ينضب، ففيه تستودع الشعوب قيما وعاداتها وتقاليدها وأنماط حياتها ورموزها التي تتجلى أساليب الطعام والأزياء والفنون وعادات الزواج ومراسم الاحتفالات وكل ما يسمى بالفولكلور الشعبي.ولا تموت الشعوب التي لديها ثقافة متجددة وقابلة للحياة في كل زمان ومكان . وهذا ما يفسر الحضور الثقافي الرافدي المتميز في مهرجان لاهي إذ سعدت بالاستماع إلى قصائد جميلة باللهجة العراقية وبعضها بالمصرية وبعضها بالسودانية وتعرفت في المهرجان على اصدقاء وصديقات من بغداد التي تذكرتها معهم بشوق وحنين فضلا عن مشاهدتي للفلكلور العراقي الإبداعي المتمثل في جملة من الصناعات الحرفية اليدوية( المنسوجات الصوفية وقصبة الناي العراقية والعطور والبخور والصدف والحلي وغيرها. ومن خبرتي المتواضعة في ثقافة البلاد العربية شكل لي هذا المهرجان الثقافي فيما يشبه العصف الذهني إذ تذكرت مروري بمعظم الدول العربية من جنوب الجزيرة العربية في اليمن وعمان إلى شمالها في مصر والسودان والشام ومن بغداد في المشرق العربي إلى المغرب والجزائر في الشمال الإفريقي وما بينهما دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وفي كل البلدان الصغيرة والكبيرة التي زرتها وأهمهما بلاد الرافدين أم الدنيا لغرض الدارسة والبحث والتفرغ العلمي والمشاركة في ملتقيات ومؤتمرات ثقافية وعلمية ومكثت فيها مدد متفاوتة بالطول والقصر. سنحت لي الفرصة للتعرف على ثقافاتها المحلية المتنوعة التي تشكلت عبر التاريخ الطويل من التباعد الجغرافي والانقطاع الحضاري بين الدول العربية المستقلة بحدودها السياسية الحديثة. إذ لا حظت أن ما يفرق العرب هو السياسية وليس الثقافة فجواز السفر هو الذي يحدد الهويات السياسية للمواطنين العرب وليس لغتهم العربية أو ديانتهم الإبراهيمية. تلك الخبرة هي التي حفزتني للبحث في مشروع البحث في الحضارة بوصفها القوى التنظيمية في التاريخ إذ وجدت أن المجتمعات العربية، تزخر بجملة واسعة من القواسم الثقافية المشتركة(لكنها تفتقد الإطار السياسي الحضاري الذي ينظمها) قواسم مشتركة في اللغة والعادات والتقاليد والافكار والمعتقدات والأمنيات والاحلام والقيم والاطعمة ومع ذلك يجد المرء صعوبة في فهم معاني الكلمات والإشارات والرمز الشعبية المتداولة في الحياة اليومية في الأقطار العربية المختلفة. ثمة لهجات محلية في كل قطر عربي وربما تنويعات مختلفة للكلمات في اللهجات المحلية لكل بلد بمفردة يصعب فهمها بالنسبة للزائر الغريب فإذا لم تكن لديك ثقافة أنثروبولوجية في الأقطار العربية سوف تقع في مطبات لغوية كثيرة وانصح بقراءة الأنثربولوجيا الثقافية لمن يريد أن يفهم الاختلاف في معاني الكلمات العربية فليس لكل كلمة المعنى ذاته في الدول القطرية المختلفة. وهذا ما يستدعي الاهتمام بالدراسات الأنثروبولوجية الثقافية بين الاقطار العربية والانثروبولوجية الثقافية هي مفتاح فهم الكثير من الالغاز والرموز الثقافية الشائعة والخفية. وهذا ما أدركه علماء الأنثروبولوجيا الغربيون الذين اهتموا بدراسة الفروق السيمائية بين الثقافات الشفاهية والكتابية. ومهما كانت المشاركات الثقافية وقوتها فالحضارة تبقى هي التي تمنحها الاطار والحماية والنمو والمعنى فمعايير قياس الحضارات يكمن في موقفها من القيم الإنسانية الأساسية( حياة الإنسان وكرامته وحقوقه ؛ حق الحياة وحق العمل وحق الحرية وحق الاختيار وحق الاختلاف وحق القبول وحق الاعتراف وحق الاعتقاد وحق التفكير وحق التعبير وحق التسامح وحق السعادة ..الخ) فحيثما تحضر وتستوطن تلك الحقوق فاعلم أن ثمة حضارة وتحضر وحيثما تغيب تلك الحقوق فلا معنى ولا قيمة للحضارة المزعومة.
كنت قبل إن اعرف تجربة الهجرة والاغتراب اتعجب من حماسة المهاجرين والمغتربين وحنينهم المستمر لبلدانهم الأصلية لاسيما اولئك الحاصلين على جنسيات الدول الغربية. إذ تجده حاصل على الجنسية الأمريكية أو الكندية أو البريطانية أو الالمانية الفرنسية أو الهولندية أو السويسرية أو البلجيكية..الخ ولكنه مشغولا ليلا نهارا بقضايا وطنه الأصلي واخبار واحوال مدينته أو قريته بشغف يبعث على الدهشة والاهتمام وقد كتبت بحثا في هذه الظاهرة بعنوان ( الهجرة أو الاغتراب المزدوج) حاولت أن افهم المعاني الخفية لتلك الظاهرة الشديدة التعقيد. ظاهرة الاغتراب المزدوج وذلك من زوايا نظر منهجية متعددة سوسيولوجية وثقافية وسيكولوجية وسياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ودينية .الخ فما السبيل إلى فهم أشواق الطيور المهاجرة وحنينها الدائم لمواطنها الأصلية؟ وكيف يتدبر المهاجرون العرب في مواطنهم الجديدة حياتهم؟ وكيف يمكنهم الاندماج الحضاري في ظل تشبثهم بهوياتهم الثقافية التقليدية التي جاءوا بها من مواطنهم الأصلية؟
أن ما يقتل الثقافات ويهدد هويتها بالتمزق أكثر من أي شيء آخر، هو الانغلاق على الذات والنكوص للماضي، والسير وفق مشيئة التاريخ واقداره. إذ تعد الثقافة من بين قوى التاريخ هي القاسم المشترك بين الناس وهي الطبيعة الثانية للكائنات الإنسانية إذ لم يكن للإنسان أن يتمكن من العيش في الأرض بدون العلم والتفكير العلمي وأول قانون علمي أدركه الإنسان هو قانون مقاومة الفناء والحفاظ على البقاء.
ورغم الفرص المتاحة للمهاجرين في الدول الاوروبية إلا أنني لاحظت كيف انهم يعيشون ظاهرة (الأغتراب المزدوج) إذ لاتزال شريحة واسعة من المهاجرين العرب من مختلف الأقطاب العربية تعيش داخل “فقاعة ثقافية” مغلقة، تعتمد على استحضار ثقافة القرية أو الصحراء في حياتها اليومية، وتُقصي عن وعي أو جهل ثقافة البلد المضيف. هذا الانغلاق يُساهم في تعميق العزلة، ويُضعف فرص الاندماج الحقيقي في المجتمع. ومن الملاحظات التي استوقفتني في تأمل حياة المهاجرين في بعض الدول الأوروبية ومنها المانيا وهولندا وكندا إذ إن الكثير منهم يسابقون الزمن لتكوين انفسهم ماديا وتطوير أنفسهم مهنيا فقط، دون أن يوازي هذا التطور التمكين المعيشي والتأهيل المهني العالي إلى رقي فكري واستنارة ثقافية في الفهم والسلوك بعضهم قد يحصل على اعلى الشهادات العلمية ومنها الدكتوراه، في التخصصات المختلفة لكنه ثقافيا ما زال يفكر بطريقة اجداده في الزمن القديم. وطالما اخترت العيش في الغرب الحديث فمن المهم إن تفهم ثقافة موطنك الجديد.
وازعم إن التحدي الأكبر للمهاجر العربي في الغرب ليس في الحفاظ على ثقافات بلدانهم الأصلية فقط، بل في كيفية التفاعل الواعي مع الحضارة الجديدة، بحيث يربّي جيلًا مزدوج الوعي: منفتحًا على العالم، ومعتزًا بجذوره الثقافية الأصيلة. ومن الملح التفكير الجاد بتحقيق الاندماج الحضاري مع المجتمعات الاقامة والاندماج هنا لا يعني الذوبان في الثقافة الغربية، وتبني قيمها كما هي بل التفاعل معها بوعي نقدي ، مع الحفاظ على القيم الإيجابية للثقافة الأصيلة. وهنا تحضر نظرية التغيير وتجاوز الصدمة فالتغيير ليس دائمًا حدثًا خارجيًا بسيطًا، بل غالبًا ما يُشكل زلزالًا داخليًا يهزّ بنية الذات ويفتح أمامها أبواب القلق، التمزّق، والحزن والغضب والإحساس بالضياع والفقد والندم والعجز وربما الأمل والمقاومة تحت ضربات المواجع والالام ومنها: صدمات الحروب ومضاعفات الهزيمة، أو النزوح أو الهجرة والاغتراب ومفارقة المواطن والأحباب وغير ذلك من المواقف الحدية التي يتعرض لها الناس في حياتهم. فكيف يواجه الناس أحزانهم وصداماتهم وتحديات حياتهم القاسية؟ هذا ما حاولت فهمه وتفسيره نظرية ( منحنى الحزن وتجاوز الصدمة) في النموذج الكلاسيكي لكيوبلر-روس، يبدأ التغيير من الصدمة الأولى: تلقي خبر الفقد، المرض، أو الانفصال، لتبدأ النفس بعده في سلسلة من المراحل العاطفية والعقلية. أولها الإنكار” آلية دفاع، ردّ فعل تلقائي يرفض الاعتراف بالحقيقة. ( لا، لا لا، هذا غير ممكن. هذا لا يحدث لي، مش معقول ؟ لست مصدقا؟ قول غيرها؟ اتذكر أن صدمة ابي بوفاة محضار أخي جعلته يفقد صوبه وظل يناديه باسمه لمدة عامين ولم يصدق غيابه الأبدي???? رحمة الله عليهما والإنكار هنا ليس مجرد رغبة نفسية للسيطرة الوهمية على الواقع أو الهروب منه بل هو صرخة استباقية ضد فقدان المعنى. هو إعلان بأن المعنى القديم ما يزال قائمًا – ولو كان هشًا – وأن الذات لم تجد بعد بديلا تعبيرًا للتعبير عن الواقع الجديد. إذ ترى كيوبلر-روس في “الإنكار” آلية دفاع، ردّ فعل تلقائي يرفض الاعتراف بالحقيقة أي إن العقل يرفض تصديق الواقع لتخفيف الصدمة ويمنح النفس المصدومة هامشا للتهيئة. بعد مرحلة الإنكار تاتي مرحلتي الغضب والمساومة إذ تحاول الذات المصدومة فهم ما لا يفُهم فالغضب بوصفه ثاني مراحل التغيير النفسي ، ليس ضد العالم أو الإله، وقضاه وقدره بل ضد الفوضى التي تهدّد منطق النظام الشخصي المعتاد للكائن أما المساومة فهي لحظة “تفاوض رمزي”، حيث يُستعاد شعور زائف بالسيطرة. في كلتا المرحلتين، تحاول الأنا أن تعيد ترميم سرديتها، ولو عبر أوهام التفاوضية مع ذاتها المجروحة ففي لحظة الغضب تطلعت تعبيرات من قبيل ( لماذا أنا؟! هذا غير عادل!” انه غضب موجّه نحو الذات، الآخرين، القدر، الإله، النظام العام مشاعر إحباط، وغيرة من الآخرين، شعور بالظلم حد القنوط واليأس الذي هو ركلة القدم الأخيرة التي توجهها النفس الغاضبة إلى بؤسها. وفي المرحلة الثالثة تأتي المساومة بوصفها آلية نفسية للخروج من الأزمة ومحاولة عقلية لإيجاد حلول وهمية أو تفاوض مع القدر ( يالله خذ حياتي وأعيده! لازال في ريعان الشباب! سوف انذر بصيام العمر كله لو رجعته! لو شُفيت، سأكرّس حياتي للخير”، أو “لو سامحني، سأتغيّر..الخ وفي المرحلة الرابعة يأتي الاكتئاب بوصفه منحنى النفس الحزينة نحو التكيف أو إعادة بناء الذات وإدراك عمق الخسارة ولا جدوى الإنكار، يصاحبها مشاعر الحزن، الخمول، وفقدان المعنى؛ ما الفائدة؟ لقد ضاع كل شيء! فالاكتئاب أقرب إلى “الانهيار الوجودي”، حيث تسقط الذات في هاوية غياب المعنى. لكن في قراءات وجودية، كقراءة كامي أو سارتر، الاكتئاب ليس نهاية القصة، بل ربما يكون لحظة تحول عميقة في الموقف الوجودي من العالم لأنه يُجبر الذات على أن تعيد بناء وجودها من اللايقين. إنه لحظة تأمّل مُعذّبة، نعم، لكنها أيضًا بداية انفتاح على العمق، على ما بعد المعنى الذي كان سعيدا أن لكل إنسان معنى خاصاً عليه اكتشافه بنفسه. ويؤكد أن المعنى يمكن أن يوجد حتى في أحلك الظروف. بالنسبة لفرانكل، فإن الإنسان لا يحتاج إلى إجابة كونية مطلقة، بل إلى معنى شخصي. بهذا المعنى يغدو الأكتئاب في نموذج روس ليس حالة مرضية بل مرحلة ضرورية للتشافي وتقبل الواقع كما هو. وهنا نكون قد بلغنا المرحلة الخامسة والأخيرة كما وصفها كيوبلر-روس ( بالقبول Acceptance) نهاية مرحلة وبداية جديد بحسب كيوبلر-روس فهو ليس استسلامًا، بل اعتراف داخلي بتبدّل الواقع. هو آلية نفسية لمواصلة الحياة ( قدّر الله وما شاء فعل! الحمد الله على كل حال! لكل نفس أجلها! لقد حدث… والآن عليّ أن أواصل حياتي ، ألحّي ابقي من الميت! قُضي الأمر! ما باليد حيلة! شو أسوي! وغير ذلك من المشاعر والتعبيرات المصاحبة بالقبول والرضا النفسي بما حدث. غير أن هناك فارقًا بين “القبول النفسي” و”القبول الفلسفي”. فالأول قد يعني التكيّف، أما الثاني فقد يعني الخلق: أن تبدأ الذات في ابتكار لغة جديدة لفهم حياتها، لا أن تستكين لما هو كائن. القبول بهذا المعنى لا ينهي الأزمة، بل يحوّلها إلى نواة لهوية جديدة. هنا في قلب أوروبا الأطلسية الباردة وفي مدينة محكمة العدل الدولية لاهاي وجدنا فسحة للتعبير عن ما يجول بخواطرنا بحرية كاملة وأمن وأمان فما أجمل الدول العادلة والمستقرة ودولة هولندا الحاضنة اليوم هي ذاتها التي وصفّها إسبينوزا في كتابة السياسة واللاهوت إذ كتب " ليست الغاية القصوى للدولة أن تهيمن على الناس، ولا أن تكبح جماحهم بالرهبة، بل أن تحرر الإنسان من الخوف، حتى يعيش ويعمل آمناً مطمئناً كل الاطمئنان، دون أن يلحق به أو بجاره أي أذى. وليست غاية الدولة أن تجعل من الكائنات العقلانية حيوانات ضارية وآلات (كما هو الحال في الحرب) بل تمكين أجسامهم وأذهانهم من أداء وظيفتها في أمان، أن غايتهم أن توجد الناس ليعيشوا على العقل السليم الصادق ويمارسوه.... أن غاية الدولة حقاً هي الحرية" وجدت إن الفلسفة هنا تعاش حقا وفعلا في الحياة اليومية للناس كما حدثني صديقي الدكتور حسين السقاف اقدم يمني مقيم في هولندا منذ ثلاثين عاما. وحينما تعيش الحرية والعدالة والتسامح والصدق والنظام والقانون فلا معنى للكلام بشأنها. وهذا ما جعلني اعيد التفكير في وظيفة الفلسفة برمتها. على مدى الأعوام المنصرمة من حياتي وخبرتي المتواضعة في دراسة الفلسفة وتدريسها، تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الفلسفة هي روح الحضارة، وعلاقتهما أشبه بعلاقة الجسد بالعقل؛ فالعقل السليم بالجسم السليم، والحضارة المتعافية والمستقرة تنتج فلسفة ناضجة وجديرة بالقيمة والأهمية. فعلاقة الحضارة والفلسفة هي علاقة تبادلية التأثير والتأثر، فكما أنّ الفلسفة لا تنبت ولا تزدهر إلّا إذا تهيأت لها شروط حضارية وعوامل محددة، فكذلك هي الحضارة لا يمكن لها أن تنمو وتتطور وتزدهر بدون منظومة فلسفية متكاملة في الوجود والقيم والمعرفة. وقد كتبت في علاقة الفلسفة بالحضارة بان الفلسفة ليست مجرد ترف فكري، بل هي مشروع حضاري. العالم المضطرب. كان مهرجانا رائعا بكل المقاييس ذكرني في أيام بغداد السلام.
اغتنمت فرصة وجودي في دنهاخ فذهبت إلى البحر فكانت المفاجأة برؤية مشهد لم ارى مثله في حياتي جموع بشرية كبيرة تسير على الاقدام باتجاه البحر بسلاسة ونظام لمسافة طويلة ثلاثة كيلومترات. كان. يوماً مشمسا????️وتلك كانت قصيدتي ????????
هل تناسى الفجر موعده؟
من آخر الأحزان
يأتي الموت
في ليل الفجيعة
صامتا متسللا
لا خوف يحمله
ولا وجع الممات
يأتي ويمضي
خلسة فينا
وفي أحبابنا
والكائنات
من خارج المعنى
ومن كل الجهات
لا دمع يُذرف في
العيون الشاردات
لا حزن في الأعماق
يتأسى على الأحياء
والأموات في
مدن الشتات
الآن والأسماء
تشبه بعضها
والنَّاس ترقب صمتها
صمت القلوب الواجفات
في هذا الساعات
من خوف المدينة
وحدي أجر الخطو
صوب البحر والأمواج
اسألها بصوت هامس
ماذا جرى للحوريات؟
دقيقة مرت وآخر
بانتظار الرد
ومرت الساعات
لكن لا أحد
موحش هذا السٌبات
وفِي سماء البحر
المحٌ ومض أنجم خافتات
هل ضاقت الكلمات بالمعنى
أم إن المعاني خائفات
لا شي في اليمن السليبة
غير أصوات البنادق
والقنابل ساهرات
لا نوم يأتي في عيون الخوف
منذ الفجر أرعبها وبات
الآن أسمع صوت
بعض الطائرات
من أي نافذة يطل الشر؟
في البلد المباحة للبغاة
الصمت خيم والشوارع
والمقاهي مقفرات
لا شيء في هذي المدنية أمن
الموت في كل الزوايا
والمنايا نافذات
هل تناسى الفجر موعده؟
أم أن الليالي سادرات
أجابني صوت من الذكرى
ماذا يفيد الفجر غير
أَلَمُّوت بالمتفجرات
هل ضاقت الرؤية
وضاق الحرف والمعنى
عن فهم الرزايا النازلات؟
عطشان يا نهر الفرات
لا نجمة في الليل
تنعشني بضحكتها
ولا سكر وقات
صحراء من كل الجهات
ماذا أخبر عن بلاد
الجهل في أرجاءها
خيّم وبات
فينيقية التاريخ
ربما لحظات لتبّرح جرحها
تتحسس الضربات
في أطرافها والغائرت
وتستعيد العزم والتصميم
من بعد الحروب الداميات
لكنها لن تنثني أبدا
مثل انثناء العاهرات
مدينة البركان
والبحر العميق
غدا ستعاود التحليق
كطائر العنقاء تنهض
من هشيم النار
من بين الرفات
لتكتب مجدها المنظور
في كل المعاني واللغات
كم أحبك يامدينة يا حميمة
حائزة كل الصفات
لعدن السلامة والنجاة
بروفيسور / قاسم المحبشي..