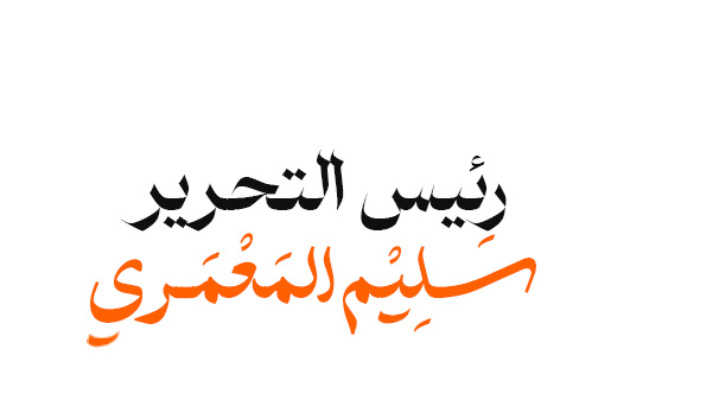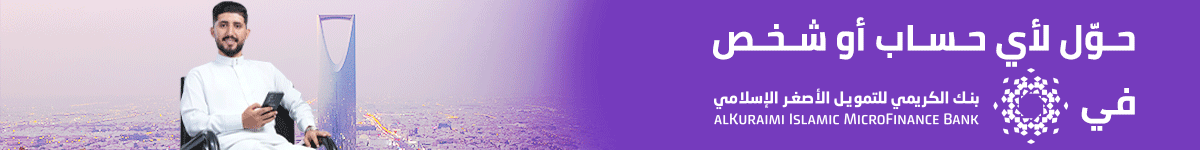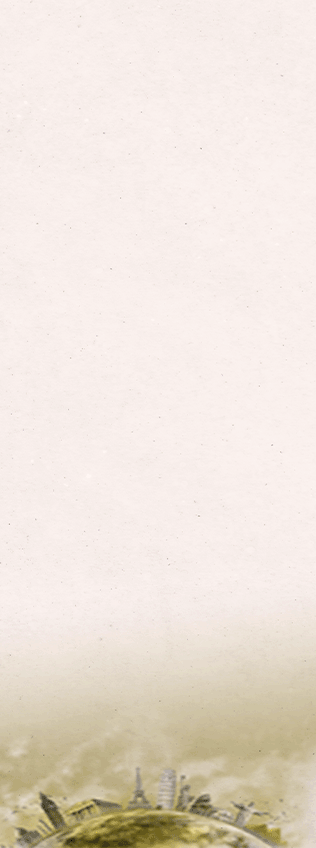فرصة سانحة لفحص المعنى بالعرض والحوار والاستجابة ..
بروفيسور / قاسم المحبشي ..
ندوة الاربعاء كانت فرصة سانحة لفحص معنى الحضارة بوصفها القوة التنظيمية في التاريخ مع نخبة متميزة من الأكاديميين والاكاديميات العرب والمهتمين ومنهم المفكر التونسي ، الدكتور عزالدين الرتيمي ، أستاذ فلسفة وباحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة في الأكاديمية التونسية وعضو في المعهد العالمي للتجديد العربي والدكتورة صبرين الجلاصي، أستاذة مساعدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة باحثة مختصة في علم اجتماع الاديان و الانثروبولوجيا الدينية وعضو في المعهد العالمي للتجديد العربي والدكتورة، هاجر منصوري أستاذة، الدراسات الحضارية، مختصة في الدراسات النسوية وقضايا الجندر وعضوة في المعهد العالمي للتجديد العربي. أدارة الندوة بكفاءة واقتدار الدكتورة، روضة الدرواز، باحثة بمرحلة الدكتوراه في اللغة والآداب والحضارة العربيّة، وعضو مقرّر بالمعهد العالمي للتجديد العربي. بحضور الأستاذة الرائعة سميرة رجب ، نائب رئيس المعهد العالمي للتجديد العربي ووزيرة الثقافة البحرينية الأسبق .وحضور الأستاذ الدكتور ، صابر مولاي أحمد، رئيس وحدة الدراسات الحضارية وعلم الاديان. وبحضور نخبة متميزة من المفكرين والباحثين والمثقفين العرب من مختلف الأقطار العربي ، من مصر والعراق واليمن وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان والسودان وليبيا وغيرها...
على مدى ساعتين ونصف الساعة احتدم النقاش بشأن الحضارة بوصفها القوة التنظيمية في التاريخ واليكم الملخص :
برهنت التجربة على ان عدم الاكتراث بمناقشة الألفاظ يصاحبه في المعتاد تشوش في الأفكار حول الأشياء ومضامينها. وهذا ما نشاهده يوميا في أي نقاش بين الأساتذة والطلبة، بل بين الأساتذة أنفسهم من خلط ولبس وإبهام بسبب عدم الاتفاق مسبقاً على المصطلح والتعريف” وتعريف المفاهيم وتحديدها هو الخطوة المنهجية الأولى في الدراسات الأكاديمية، ذلك لانها تجعلنا على بينة من امرنا، بشان معاني تلك الكلمات التي نتحدث عنها، وما دامت هناك كلمات مختلفة فلا بد من ان نعرف ونحدد دلالاتها المتمايزة. إذ أن المفاهيم لا توجد في فلك الأفكار ومدونات اللغات فحسب، بل هي كائنات تاريخية شديدة الارتباط بسياقاتها الاجتماعية الثقافية المشخصة، ولكل مفهوم مكان وزمان ولادة وسياق نمو وتجربة ممارسة وعلاقات قوة وسلطة معرفة ونظام خطاب ومدونة لغة وفضاء فكر وحساسية ثقافة وحقل تأويل وشفرة معنى وأفق دلالة.. الخ..
غير أن مشكلة الإنسان مع المفاهيم المجردة تكمن في اعتقاده بانه يعرفها بمجرد النطق وحينما يسأل نفسه عن معناها؟ يكتشف جهله بمعناها الحقيقي وتلك هي قضية سقراط الذي أكد أن الفلسفة هي التي تعلمنا جهلنا ومعرفة الإنسان بجهله الذاتي هو الخطوة الأولى لتفتح العقل وفهم العالم. تداعت تلك الفكرة إلى ذهني وأنا ابعث في مفهوم الحضارة وتحولاته في السياقات التاريخية المختلفة فلا يوجد معنى واحد للمفهوم في كل السياقات والعصور...
وأنا أبحث في مفاهيم الحضارة والثقافة والمدنية؛ قوى التاريخ الأساسية وعناصره الفاعلة وجدت أن الكثيرين من الباحثين والكتاب يخلطون بينها إذ يتم الخلط بين قوى التاريخ وعناصر خلطاً تفقد به الأسماء الدلالة على المسميات ولا تدل به المسميات على أسمائها، وفي هذا ما فيه من تعطيل لغة الكلام بقعودها عن القيام بوظيفتها المعرفية العلمية وعن مواكبة حركة التاريخ والتقدم الثقافي وقد وجدنا من هذا الخلط أن الملا الثقافي يتحدثون عن الحضارة ولا يقصدون في حقيقة الأمر إلا الثقافة أو المدنية والثقافة معاً، أو المدنية والثقافة ومعهما الحضارة ويتحدثون عن الثقافة ولا يقصدون في حقيقة الأمر إلا الحضارة أو المدنية أو الحضارة والمدنية، ومعهما الثقافة ويتحدثون عن المدنية ولا يقصدون في حقيقة الأمر إلا الثقافة والحضارة أو الثقافة والحضارة معاً وينجم عن هذا الخلط بين المفاهيم والمعاني كثير من الإبهام والتشوش في الأفكار والآراء والتصورات والكلمات فكيف يمكن لنا التفريق بين الكلمات والأشياء والمفاهيم والدلالات التي تعنيها...
غني عن البيان أن العلاقة بين الحضارة والثقافة والمدنية بوصفها قوى التاريخ وعناصر الفاعلة هي علاقة عضوية شديدة التداخل والتفاعل والتأثير والتأثر إلى درجة تعي القدرة على رؤية التمايز والاختلاف بينها وهذا يستدعي المزيد من التأمل والتبصر في شبكة العلاقة وفك خيوطها المتداخلة من زاوية نظر منهجية وظيفية وهذا هو ما تمكن من إنجازه الأستاذ مدني صالح في نظريته الفلسفية للتاريخ إذ بين ان الحضارة سياسة وأخلاقًا وتشريعا هي القوة التنظيمية في التاريخ وأول الحضارة هو الإحساس بالخوف من عاقبة الاعتداء على الآخرين ومن الضرر الذي يصيب الإنسان من اعتداء الآخرين عليه وهو الخوف الذي نعبر عنه بالضمير والوازع ومخافة الأذى والضرر جراء القيام بالذي صار اسمه بعدما لا يحصى من الزمن والخبرات والتجارب حراما وعيبا وممنوعا ولا يجوز” ..
ويذهب فرويد إلى إن الحضارة بدأت حينما بدأ الإنسان في تنظيم دوافعه الغريزية عن طريق مجموعة من النواهي والتابو والقانون” أننا لا نعدم البراهين التاريخية التي تدعم فرضيتنا القائلة بأن الحضارة هي القوة التنظيمية في التاريخ قوة تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية هي (السياسة والأخلاق, التشريع) فهذا عالم الاجتماع الفرنسي(غي روشية), يعرف الحضارة بأنها ” تضم مجموع الوسائل الجماعية التي يلجأ إليها الإنسان حتى يمارس سيطرة على نفسه وينمو نمواً عقلياً وأخلاقياً وروحياً” والحضارة هي قدرة الإنسان في السيطرة على نفسه السيطرة التي لا تكون إلا بمعرفة قوانين التطور التاريخ والحياة الاجتماعية وتوظيفها في تحسين بيئة الحياة الإنسانية الجديرة بالعيش والتنمية.
والثقافة علما وأدبًا وفنا هي القوة الإبداعية في التاريخ وتشتمل على كل ما أبدعه وابتكره الإنسان من لغة وأفكار ومعارف وقيم وعادات وتقاليد ونظم ومؤسسات وعلاقات ومعتقدات وكل شيء ما فوق طبيعي وهي بذلك أوسع مفهوم من الحضارة والمدنية.أما المدنية فهي القوة المادية في بوصفها زراعة وتدجين وتعدين وصناعة وعمارة وكل ما يتصل بالإنتاج والبناء وأدواته ووسائله...
وليس للحضارة جوهرا ثابتا دائما في كل العصور بل يختلف معناها بحسب السياقات التاريخية المختلفة فاذا كانت تعني في الأزمنة القديمة قوة النظام السياسي وقدرته الإمبراطورية في فرض السيطرة وشن الحروب التوسعية فإنها تعني اليوم كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية؛ حق الحياة وحق العمل وحق الحرية وحق الاختيار وحق الاختلاف وحق القبول وحق الاعتراف وحق الاعتقاد وحق التفكير وحق التعبير وحق التسامح وحق السعادة ..الخ) ..
فحيثما تحضر وتستوطن تلك الحقوق فاعلم أن ثمة حضارة وتحضر وحيثما تغيب تلك الحقوق فلا معنى ولا قيمة للحضارة المزعومة...
فإذا كانت الحضارة في مصر القديمة تعني إلهة العدل «ماعت» ففي اورك كانت تعني العيش بالمدينة لقد كانت مدينة أوروك المحصنة بالأسوار العالية وجلجامش ” الحكيم العارف بكل شيء بطل أوروك وحاميها ” في أسطورة جلجامش تمثل المرأة “الحضارة مقابل التوحش والبداوة التي كان يمثلها ” انكيدو ” الذي يجوب البراري والتلال يرعى الكلأ مع حيوان البر ويستقي معها عند موارد الماء ذلك المتوحش القوي، الذي استأنس أول ما استأنس بالمرأة “البغي” رمزاً من رموز الحضارة المستقرة، وحينما رقد “انكيدو” على فراش الموت، وأدرك قرب نهايته أخذت تتوارد عليه الخواطر والذكريات، فود لو انه ما جاء إلى حياة (الحضارة) بل ظل في باديته سعيداً خالي البال يرعى مع الظباء والحيوان، واخذ يكيل اللعنات على من زين له الملجئ إلى حياة المدينة ” ..
ومن هذه الرغبة في التمييز بين نحن وهم نبعث فكرة الشعب المختار عند اليهود إذ أن الفكر اليهودي منذ بدء التاريخ قسم العالم إلى ( أنا والاغيار ” اليهودي والحوييم وهذا الأخير لا يمكن له أن يفهم التوراة ووصاياها وأن تكون متحضراً كان في الأصل يعني أنك تعيش في ظل القانون الروماني أو في الحاضرة اليونانية وكان أهل اليونان يميزون أنفسهم عن سائر الشعوب الأخرى ” البربرية ” بأنهم وحدهم أهل الحضارة وهي على أسلوب في الحياة والعيش متميزاً ومختلف عن الآخرين. وقد حدد الأثينيون العناصر الثقافية الأساسية التي تعرف الحضارة على شكل كلاسيكي، عندما أكدوا لأهل ” اسبرطة ” أنهم لن يفشوا أمرهم للفرس، إذ أن هناك اعتبارات كثيرة وقوية تمنعنا من أن نفعل ذلك حتى لو كنا نريد. أولاً وأساساً هناك صور منازل الآلهة، الآثار المحروقة والمدفونة هذه تحتاج إلى أن ننتقم لها بأقصى ما نستطيع بدلاً من أن نصل إلى تفاهم مع من أرتكب تلك الأفعال. ثانياً الجنس الإغريقي من نفس الدم واللغة نفسها عموماً وعاداتنا المتشابهة..
ولن يخون الأثينيون ذلك أبداً” وقد كانت روما المسيحية عند القديس أوغسطين هي ” مدينة الله ” مقابل مدينة الشيطان البابلية المدنية الأرضية، المدنية السياسية المدنسة” والحضارة في لسان العرب نقيض البداوة وتعني العيش في الحاضرة وهي عند ابن خلدون غاية العمران وسبب خرابه ولها معنيان: معنى الاستقرار في المدن وقيام الدول ومعنى التفنن والتأنق والمبالغة في عوائد الترف والانكباب على المتع والشهوات واللائذ سواء كان ذلك في المشرب أو المأكل أو المسكن والملبس والمغتنيات الصناعية والفنية والخدمية” وهي عند شبنجلر روح الشعب وثقافته والحضارة عند ألبرت اشيفيتسر هي ” التقدم الروحي والمادي للأفراد والمجتمعات على حد سواء. والحضارة عند توينبي وحدة التاريخ الأساسية التي تعني النظام السياسي أو الامبراطوري العام فما هو معنى الحضارة اليوم؟..
يذهب رولان بريتون في كتابه «جغرافيا الحضارات» إلى أن «كلمة الحضارة civlisation ظهرت سنة 1734م، وهي تنحدر مباشرة من صفة حضري المشتقة من اللاتينية مثل civilite، وcite مدينة – حاضرة». إذاً فمنذ البداية ارتبط مفهوم الانتماء إلى المدنية بجماعة منظمة، تمثل الدولة المدنية، أو تقوم مقامها دلالياً بمعنى التهذيب والتحضر، ومن هنا جاء معنى الكلمة اليونانية «polis» مدينة – حاضرة دولة، ومنها اشتقت الكلمة اللاتينية «politus» صيغة فعل «polin» هذَّبَ، مدَّنَ، وكلمة «politesse» التي مزجت وعدَّلت وميَّزت شيئاً فشيئاً بين مفاهيم التهذيب واللياقة وحُسن الأداء، ومفاهيم النظام العام والدولة والمدنية والحاضرة.وأخيراً وُلِدَت كلمة «civilisation» حضارة من فعل «civilisen» حضر، وهي ترسم في أسرة الكلمات المتحدرة من كلمة «cite» حاضرة، معالم اشتقاقية تدور حول مفاهيم التربية «education» والترقي والتطور والتقدم والحالة المتقدمة المتفوقة، فالحضارة هي أولاً «فعل تحضير»، ومسار تصاعدي وتقدمي، يرمي من خلال التغيير إلى احتواء وإدماج أولئك الذين يظلون خارجها في البراري والأرياف والغابات، «المتوحشون البريون salvaticus»،..
ثم إن الحضارة هي جملة الصفات المكتسبة خارج الطبيعية، وهي أخيراً مجموع الظواهر المميزة للحياة في هذا العالم الخاص المتطور الذي بناه الإنسان المدني. وربما كان المجمع الفرنسي في معجمه المنشور عام 1933م قد أسدى خيراً عندما عرَّف كلمة الثقافة تمييزاً لها عن الحضارة بالآتي: إن كلمة ثقافة تطلق مجازاً على الجهد المبذول في سبيل تحسين العلوم والفنون وتنمية المواهب الفكرية ومواهب العقل والذكاء. وهذا هو المعنى الذي قصدناه بقولنا إن الثقافة هي القوة الإبداعية في التاريخ، وهي كل ما نشهده من تطور دائم مستمر في العلم والفن والأدب...
ما يهمنا هنا هو التأكيد على أن الحضارة من حيث المفهوم والسياق التاريخي تتميز عن مفهومَي الثقافة والمدنية لكونها تتصل اتصالاً لازماً بشكل التنظيم السياسي والقانوني والأخلاقي للمجتمع، إنها تعني العيش في مجتمع سياسي منظم بالدستور والقانون والضمير الأخلاقي، فكلما كان التنظيم الاجتماعي خاضعاً للقانون كلما كان أكثر تحضراً، وقد بدأت الحضارات في التاريخ بوجود الدولة الإمبراطورية في الشرق القديم، ويذهب أرنولد توينبي إلى أن الحضارة هي الوحدة الأساسية في دراسته للتاريخ إذ إن كلمة حضارة عنده ارتبطت بقدرة المجتمع على تنظيم نفسه سياسياً واجتماعياً وثقافياً في دول كبيرة، وعنده أن إفريقياً السوداء بهذا المعنى عرفت ثقافات، ولكنها لم تعرف حضارات.
وعلى هذا النحو يمكن القول إن الحضارة والثقافة والمدنية، هي قوى وعناصر التاريخ، وما عناصر التاريخ إلا وسائله وأسبابه وغاياته وقواه التي يتطور بها صاعداً في معارج التقدم والتطور والارتقاء، وهي: الثقافة علماً وأدباً وفناً: هي القوة الإبداعية في التاريخ، والتطور الدائم المستمر في العلم والأدب والفن. والحضارة: سياسةً وأخلاقاً وتشريعاً: هي قوة التاريخ التنظيمية، والتطور الدائم المستمر في السياسة والأخلاق والتشريع والمدنية: زراعةً وصناعةً وعمارةً: هي قوة التاريخ المادية السلعية والتطور الدائم المستمر في الزراعة والصناعة والعمارة والتعدين والتدجين. ولا يكون التاريخ بهذا التعريف إلا مجمل خبرات الإنسان في الثقافة، والحضارة، والمدنية، وهي عناصر التاريخ التي منها يتكوَّن، ومنها لا من غيرها يستمد قواه الفاعلة في جميع ظروف الزمان والمكان والحركة والفعل ورد الفعل والتطور والتكيف واتخاذ الموقف، وهذا ما استخلصه المفكر العربي الراحل مدني صالح...
وحينما نقرأ كتاب الأمريكي جيمس هنري بريستيد فجر الضمير يمكننا أن نفهم معنى الحضارة والتحضر والمؤسسات إذ يرى المؤلف أن نهوض الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ ما يسميه رجال اللاهوت بعصر الوحي بزمن طويل «ويقول المؤلف إن ذلك النهوض الحضاري في وادي النيل يرجع قبل «عصر وحي رجال اللاهوت» بألفي سنة على الأقل وأكد بريستيد أن المصريين القدماء سعوا إلى وضع مجموعة من القيم والمبادئ التى تحكم إطار حياتهم، تلك القيم التى سبقت «الوصايا العشر» بنحو ألف عام، وقد تجلى حرص المصرى القديم على إبراز أهمية القيم فى المظاهر الحياتية، فكان أهم ما فى وصية الأب قبل وفاته الجانب الأخلاقى، حيث نجد الكثير من الحكماء والفراعنة يوصون أبناءهم بالعدل والتقوى. كذلك كانوا يحرصون على توضيح خلود تلك القيم فى عالم الموت. لذا نحتوا على جدران مقابرهم رمز إلهة العدل «ماعت» ليتذكروا أن العمل باقٍ معهم...
وهكذا كانت الحضارة ومعناها هي النظام العام بوصفها سياسيةً وتشريعا وأخلاقًا أي النظام الذي يحفظ ويصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية؛ حق الحياة والعمل والحرية والفكر والاعتقاد والتعبير فضلا عن الحقوق المدنية المكفولة في إطار القانون سيد الجميع...